بحسب الأرقام المعلنة من طرف السلطة الوطنية "المستقلة" المشرفة على الانتخابات، فإن نسبة المشاركة كانت بكل المقاييس متدنيةً في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الجزائر يوم 12/12/2019م بخمسة مرشحين متسابقين أبرزهم عبد المجيد تبون وعلي بن فليس (كلاهما رئيس حكومة سابق) في أجواء مشحونة بالسخط والرفض في الشارع بشكل غير مسبوقٍ بعد أزيد من تسعة أشهر من الاحتجاج بنفس الشعارات والمطالب على منظومة الحكم الفاسدة في البلد. فقد كانت نسبة المشاركة والإقبال على صناديق الاقتراع بعد فرز الأصوات 39.83% من عدد المسجلين في القوائم الانتخابية البالغ عددهم 24.4 مليوناً داخل البلد وخارجه، باحتساب الجالية. وهو ما يعني أن عدد المقاطعين اقترب من 15 مليوناً من مجمل الكتلة الانتخابية! وكانت نتيجة الاقتراع قد حُسمت في الدور الأول وفق مقتضيات المرحلة وإملاءات أصحاب القرار بفوز المرشح "الحر" عبد المجيد تبون بـنسبة 58.15%. يجدر الذكر أن الفائز بمنصب الرئاسة في هذا الظرف الاستثنائي هو ابن جبهة التحرير الوطني التي هي دوماً أداة الفعل السياسي للسلطة في الجزائر، حتى وإن غابت عن المشهد. فهو بهذا الفوز يجسد على أرض الواقع استمرار الزمرة نفسها في الحكم، وهو المتمرس في الإدارة طوال حكم بوتفليقة بل قبل ذلك، وهو المقرب من الزمرة النافذة التابعة للإنجليز والقريب من دواليب السلطة، الذي كان قد أُسندت له رئاسة الحكومة في 2017م، إلا أنه لم يعمر في ذلك المنصب سوى ثمانين يوماً، حيث أزيح بسبب مناهضته لنفوذ رجال الأعمال وما قيل حينها عن عزمه فصل المال عن السياسة بعد تغول أصحاب المال الفاسد في المنظومة البوتفليقية السابقة. فكأنه كان بتلك الحادثة يُهيأ من طرف أصحاب القرار للدور الذي أُسند إليه ويلعبه الآن! فأي "جزائر جديدة" تعد بها السلطة إذن؟
الجدير بالذكر أيضاً هو أن السلطة تفننت في ابتكار أساليب جديدة في مصادرة الإرادة الشعبية عبر رسم كل محطات المسار من أوله إلى آخره بطرق ذكية بدءاً بتفصيل قانون الانتخابات وإنشاء السلطة المستقلة المشرفة عليها بدل وزارة الداخلية التي أُبعدت هذه المرة تماماً ولو في الظاهر عن الإشراف على الانتخابات، ثم عبر تسخير جهاز العدالة في المحاكمات المتتابعة للخصوم ورموز الفساد، والتلاعب بالصحافة والإعلام بالأوامر والتوجيه وشراء الذمم والتضليل والدعاية، وعبر ضبط طريقة سحب الاستمارات وحصر المرشحين في عدد من أزلام السلطة ثم ترتيب مناظرة متلفزة للمتسابقين عشية الانتخابات، ليظهر للجميع أن نتيجة الانتخابات لن تعرف هذه المرة إلا يوم الاقتراع، وهو ما أضفى عليها عند العامة طابع الشفافية والنزاهة. وقد بدا جلياً طوال كل هذه الفترة أن همَّ السلطة الفعلية كان وبكل تأكيد إجراء الانتخابات في موعدها وبأي ثمن، وذلك من أجل اكتساب الشرعية اللازمة للمرحلة المقبلة. إلا أن عبد المجيد تبون وبعد تسلمه الرئاسة سوف يواجه دون شك مهمة صعبةً للغاية، إذ سيكون حتماً في مواجهة الحراك المصمم على مطالبه في الشارع، فضلاً عن مواجهة اختبار تحقيق وعوده الانتخابية التي على رأسها حل معضلة النهوض بالاقتصاد، واسترجاع الأموال المنهوبة التي قال إنه يعرف كيف يستردها، وحل مشكلة البطالة في أوساط الشباب، وبعث منظومة التعليم،... وغير ذلك من التحديات. علماً أنه تردد على لسانه مراراً خلال الحملة الانتخابية أن هذا الحراك السلمي المبارك جاء في الوقت المناسب ليخلص البلاد والعباد من العصابة التي عبثت بمقدرات الجزائر. وإذ صرح الرئيس الجديد أيضاً في تناغم مع المؤسسة العسكرية أنه يريد إنشاء "جزائر جديدة"، وأن من أولوياته إجراء تعديل دستوري يحد من صلاحيات الرئيس "الإمبراطورية" وإدخال تغييرات جذرية على قانون الانتخاب، فإن البلد قد يكون على موعد مع فصول جديدة من التحولات والتجارب على الشعب! وهل يمتلك تبون حقاً مفاتيح التغيير في الجزائر؟
وجب التذكير هنا بأن المؤسسة العسكرية وصلت إلى هذه المحطة (تنظيم الانتخابات الرئاسية) بعدما كانت قد ألقت بكل ثقلها في الساحة السياسية من خلال خطابات رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح المتتالية من الثكنات من مختلف النواحي العسكرية عبر أشهر، وبتفعيل المواد الدستورية ذات العلاقة لإزاحة بوتفليقة الذي حكم الجزائر عشرين عاماً، عن المشهد، وذلك بعدما قام بضرب الخصوم ونعتهم بأذناب الاستعمار الفرنسي وبتهيئة الأجواء وامتصاص غضب الناس في الشارع وتقليص زخم الحراك لقبول رؤية سلطة الأمر الواقع عبر ندوة للحوار، ثم عبر إنشاء ما سمي "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" برئاسة وزير العدل الأسبق محمد شرفي التي كانت تتويجاً لما تمخض عن جهود هيئة الحوار والوساطة التي قادها على مدى أسابيع الوزيرُ السابق كريم يونس. من خلال كل ذلك ومن خلال تبني فكرة "مرافقة" الحَراك وخدعة الاستجابة لمطالبه منذ انطلاقته والتحذير من عواقب تأجيل العودة إلى المسار الدستوري ومن مخاطر عدم الاستقرار، تمكنت السلطة الفعلية المتمثلة في المؤسسة العسكرية الممسكة بالبلد من الوصول إلى إمضاء خارطةِ الطريق المرسومة المتمثلة أولاً في إجراء الانتخابات الرئاسية، رافضةً أية مرحلة انتقالية لطالما طالب بها الخصوم، بل مستعجلةً إجراءها في موعدها ومستخدمةً أساليب ذكية في إخفاء دورها فيها.
أما من جانب الحراك، فإنه قطعاً لن يذهب بعيداً في تحقيق التغيير المنشود. ولكن يبدو أنه سوف يستمر لبعض الوقت في انتظار ما سيقوم به الرئيس الجديد من إجراءات ملموسة لتحسين الأوضاع وتحقيق "مد يده إلى الحراك الشعبي" كما وعد. كما يمكن القول بالجملة إن الحراك الشعبي في الجزائر وقع في مطب حصر الفساد في السطو على المال العام دون غيره، وفي مطب تسقيف الانتماء والولاء والهوية بالفكرة الوطنية الهابطة، وإعادة بناء الدولة على ذلك، متجاهلاً مسألة استرجاع بل تفعيل الهوية الحقيقية لأهل البلاد المتمثلة في الإسلام عقيدةً ونظاماً للحياة. وهو ما يعني عدمَ تفعيل عوامل القوة الحقيقية الكامنة في الأمة الإسلامية، المستهدَفة أصلاً من المستعمِر الغربي بهذه الشَّرذمة والتقسيم. كما أنه وقع في مطب مطلب الدولة المدنية، التي تعني لدى جزء من المنخرطين في الحراك إبعادَ العسكر عن السياسة، وعند الجزء الآخر إبعاد الأيديولوجيا عن المطالب، وفي كلتا الحالتين المستهدف هو الإسلام. إذ يبدو أن الخلفية ليست إلا استنباطاً من الواقع وتأثراً بفكر الغرب وما راج بين "الإسلاميين" مما توصلوا إليه بسبب الواقعية من نتائج بعد فشلهم في تجارب عديدة مرتمن أن العسكر يجب أن يبتعدوا أو يُبعدوا عن السياسة، وأن الحكم المدني في البلاد هو الحل، وأن الجيوش في البلاد الإسلامية لا خير فيها، إذ هي دائماً رهن إشارة الحاكم الظالم المرتبط بأسياده في الغرب، كما أنها تصطف في كل انتفاضة شعبية على الظلم والفساد دوماً مع الحكام الطغاة المستبدين، وهو ما حدث على سبيل المثال في مصر وقبل ذلك في الجزائر مع جبهة الإنقاذ في لحظة الصدام مع ما يريده الشعب المسلم، وذلك أن "الإسٍلاميين" كادوا أن يصلوا "ديمقراطياً" إلى الحكم في الجزائر لولا تدخل العسكر، الذين أجهضوا ما سمي "التجربة الديمقراطية"، بل إنهم وصلوا فعلاً عبر الصناديق إلى سدة الحكم في مصر، ولكن العسكر تدخلوا في العملية مجدداً وأزاحوا مرشح الإخوان وحالوا دون نجاح العملية، أي حالوا دون بقاء مَن اختارهم الشعبُ في السلطة.
ولكن إذا علمنا أن الجيوش عامةً هي التي تمثل أهل القوة في كافة البلدان، وأن طلب النصرة من أصحابها في بلاد المسلمين من أجل إقامة حكم الإسلام إنما يكون من هذه الجيوش، وهو ما يبدو في نظر كثير من "الإسلاميين" المولعين بالفكر الديمقراطي فكرةً خياليةً سخيفةً مثيرة للسخرية والضحك، مع أنها حكم شرعي، وإذا علمنا أن الغرب بعدما أزاح الإسلام عن الحكم بهدم الخلافة، ثم أنشأ على أنقاضها هذه الدول الوطنية الهزيلة الموجودة الآن، إنما عمد إلى تسليم الحكم عملياً للعسكريين الموالين له، بواجهة مدنية. وإذا علمنا أيضاً أن العقلية العسكرية لا تصلح لتسيير الشأن العام، وأنها تختلف عن العقلية السياسية، إذا علمنا كل ذلك، وصلنا إلى معرفة سبب زلة المسلمين ووقوعهم في هذه المطبات اليوم. علماً أن الحكم الشرعي في كيفية أخذ الحكم إنما هو طلبُ نصرة من يمتلك القوة الفعليةَ في البلاد، وهو الجيش، وذلك من أجل إقامة الدولة على أساس الإسلام في بلاد المسلمين وضمان بقائها، وهذا هو الحل الشرعي الصحيح.إلا أن هذه الإشكالية ليست هي المعضلة الوحيدة في بلاد المسلمين، فقد تعمَّد الغرب بعدما استلم البلاد تضليلَ الأمة وخلطَ المفاهيم في أذهان المسلمين في كافة مناحي الحياة وعلى جميع المستويات، وذلك بواسطة الحكام العملاء وأذنابهم الذين باتوا الحاجز الأول أمام حـمَلة أمانةِ إعادةِ الأمة إلى دينها ومكانتها وسابق مجدها، هذه العودة إلى الإسلام التي لا تعني عند مَن منَّ الله عليهم بفهم طريقة العودة إلى الدين وتصحيح مسار الأمة وإعادتها إلى السكة ووضعها على الصراط المستقيم سوى إقامة دولة الخلافة مجدداً، التي بها يتحقق تطبيقُ نظام الإسلام.
بقلم: الأستاذ صالح عبد الرحيم – الجزائر



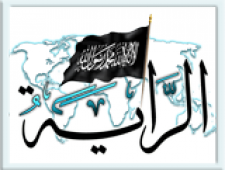

























رأيك في الموضوع