إنّ تأسيس الدول القومية والوطنية في أوروبا على أساس النظام الديمقراطي الرأسمالي بعد توقيع معاهدة وستفاليا في العام ١٦٤٨م فتح المجال واسعاً لوجود ما يُسمّى بالدولة العميقة، باعتبارها دولة أخرى داخل الدولة الأصلية، ذلك أنّ مفهوم الدولة بعد معاهدة وستفاليا أصبح يعتمد على وجود عدة مؤسّسات حاكمة، وليس على مؤسّسة واحدة، فتم تقسيم صلاحيات الحكم وتوزيعه على مؤسسات عدة؛ فالحاكم في الدولة ليس هو الرئيس أو الملك أو رئيس الوزراء فقط، وإنّما هو مجموع المؤسسات المكوِّنة للدولة؛ فالحكومة مؤسسة، والبرلمان مؤسسة، والقضاء مؤسسة، والجيش مؤسسة، والأمن مؤسسة، وكل واحدة من هذه المؤسسات يمكن أن تُقسم إلى وحدات مُؤسّسية أصغر منها؛ فالحكومة فيها وزارات، وكل وزارة فيها مؤسسة مُستقلة لها صلاحية الحكم في الحقيبة الوزارية المسؤولة عنها، والبرلمان فيه مؤسستان حاكمتان لهما صلاحيات واسعة، وهما النواب والأعيان (الشيوخ أو اللوردات)، والأمن كمؤسسة فيها أجهزة مخابرات للداخل وأخرى للخارج، وكل منهما تمتلك صلاحيات واسعة في الحكم، والجيش فيه مجموعات عسكرية شبه مستقلة تحكم الجنود والضباط فيها كالوحدات النظامية والحرس الجمهوري والقوات الخاصة وما شابه ذلك، والقضاء تنقسم المحاكم فيه إلى محاكم جزائية ومحاكم عليا، وتمتلك كل منها صلاحيات كبيرة، والنقابات المتعددة هي الأخرى تمتلك صلاحيات قانونية في رعاية شؤون العمال والمهنيين... وهكذا تمّ تقسيم السلطة في النظام الرأسمالي إلى مجموعة مؤسسات حاكمة مفصولة عن بعضها البعض، يضمن القانون العام استقلاليتها بشكلٍ كامل، وهو ما يُسمونه بالفصل بين السلطات، واستقلالها، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تداخل أو تضارب في الصلاحيات داخل نظام الحكم، وينتج عنه في العادة ضعف وتخبط في صدور القرارات، وقصور في الأداء.
ولكن أخطر ما في هذا النوع من النظام المُؤسسي هو وجود إمكانيات كبيرة لتشكيل تحالفات سرية بين القائمين على إدارة المُؤسسات للقيام بتعطيل سير عمل الحكومة، أو حتى الانقلاب عليها، وهذه التحالفات هي التي يُطلق عليها عادةً الدولة العميقة، فتجمُّع بعض عناصر من مؤسسات الدولة من أصحاب المصالح المشتركة في تحالفات خفية أو مُعلنة، هو الذي يوجد الازدواجية في الحكم، أو ما بات يُعرف بدولة داخل الدولة.
وإذا كان هذا الخطر بسبب استقلال المؤسسات مُسيطراً عليه في الدول المتقدمة نوعاً ما، فإنّه في دول العالم الثالث يخرج عن السيطرة تماماً، بل إنّ الدولة العميقة قد تتحكم بشكلٍ مطلق ودائمي بالدولة الرسمية، وما كان يجري في تركيا في النصف الثاني من القرن العشرين، وما جرى في الجزائر في العشرية السوداء في تسعينات القرن الماضي، وما حدث لثورات مصر وتونس وليبيا ما هو إلا شكل من أشكال تحكم وسيطرة الدولة العميقة على الحكم خاصة عند اهتزازه جماهيرياً، لذلك كان التغيير الجزئي أو الترقيعي في هذه الدول هو ضرباً من ضروب العبث، بل هو غالباً ما يؤدي إلى تقوية تلك الدول بدلاً من الثورات، وكان التغيير الجذري الانقلابي الشامل هو الحل الوحيد في مثل هذه الأحوال.
أمّا في الإسلام فلا مجال لوجود الدولة العميقة في نظام الحكم، لأنّ نظام الدولة في الإسلام هو ببساطة ليس نظام مؤسسات، بل هو نظام يعتمد على شخص الخليفة الذي ينوب عن الأمة في تطبيق أحكام الشرع، فالخليفة هو الدولة والدولة هي الخليفة، والمؤسّسات في دولة الخلافة هي مؤسّسات إدارة لا مؤسسات حكم، وكلها تُعاون الخليفة في الحكم ولا تُشاركه إياه.
ومن جهةٍ أخرى فإنّ عدم وجود مؤسسات حكم في دولة الإسلام لا يعني وجود الدكتاتورية، لأنّ الخليفة لا يحكم بهواه، وإنّما يحكم بشرع الله، ومن يحكم بالشرع لا يمكن أن يكون دكتاتوراً، فكما أنّه مطلوب من الخليفة حكم الناس بالشرع، فكذلك مطلوبٌ من جميع أفراد الرعية الخضوع لحكم الشرع، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾، وهذا يعني أنّ السيادة في الدولة الإسلامية لا تكون إلا للشرع، فلا مكان فيها للعقل أو الهوى، ولا مجال فيها للفردية والجبر والاستبداد، لأن حكم الشرع يقي من وجود مثل كل هذه الآفات.
ومن هنا يمكن القول إنّه لا مكان في دولة الخلافة للدولة العميقة، فلا مجال لوجودها، ولا خطر من تسربها إلى جسم الدولة، لأنّ دولة الخلافة ليست دولة مؤسسات أولاً، وثانياً لأنّه لا مكان لوجود الروابط الوطنية أو القومية الهدّامة فيها، فالإسلام هو القاعدة الوحيدة التي يُعتدّ بها في الدولة، وخطر وجود مؤسسات تتبنى تلك الروابط المفرِّقة والممزقة لوحدة الدولة غير وارد لانعدام وجودها، وما جرى في أوروبا من قيام دول قومية ووطنية على أساس تعدد الحكم فيها بتعدد المؤسسات، لا ينطبق على بلاد المسلمين بحال من الأحوال، فنظام الحكم في الإسلام أساسه العقيدة الإسلامية، بينما في الدول القومية والوطنية أساسه فصل العقيدة عن الحكم، وتوزيع صلاحيات الحاكم على المؤسسات، وجعل حدود الوطن أو رابطة الدم هما الأساس المقدس الذي اعتُبر قاعدة لحكم جميع المؤسسات عوضاً عن رابطة الدين والعقيدة.
وهذا هو السبب الذي جعل أي عملية تغيير إصلاحية أو جزئية في الدول القومية والوطنية محكوماً عليها بالفشل، لأنّ الدولة العميقة المُتجذرة داخل هذه الدول لن تسمح لعملية التغيير الجزئية بالمرور، أو هدمها، ومن هنا كان لا بُد من هدم هذه الدول أولاً في أي عملية تغيير، وذلك قبل الشروع ببناء دولة الإسلام على أنقاضها.



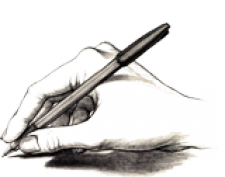

























رأيك في الموضوع