كلما مرت بي ذكرى الإسراء والمعراج، تقفز إلى ذهني أسئلة ملحة: لماذا كان يجب أن يكون الإسراء من الأقصى وليس من مكة؟ ولماذا عاد رسولنا ﷺ من المعراج إلى الأقصى مجددا ثم منه إلى مكة؟ وإذا كان ﷺ سيلتقي بالأنبياء في السماوات أثناء المعراج، فلماذا كان لازما أن يحييهم الله ليصلي بهم ﷺ في الأرض داخل المسجد الأقصى قبيل معراجه مع أنه سيلتقيهم واحدا واحدا في كل سماء؟
إن المدقق في رسائل هذه الرحلة العظيمة، والمستقرئ لأحداث أعظم اجتماع قمة في التاريخ، اجتماع حوت جدران الأقصى فيه - وهو يرزح تحت الاحتلال الرومي - أشرف من وطئ الثرى، ليجد بشكل جلي جلاء النور للظلمات أن هذه الفصول كانت تهدف لتكريس حقيقتين دامغتين:
1- أنت يا رسول الله، قائد لجميع رسالات هؤلاء الأنبياء، وأمتك أمينة على سائر الأمم.
2- أمانة المسجد الأقصى هي في أعناق أمتك يا سيد المرسلين.
لأجل ذلك لم يكن غريبا أن يتسابق الخلفاء والقادة لتحرير هذا الحرم الشريف، وتسطر صفحات التاريخ النصر وراء النصر على أعتابه الطاهرة.
وقد جاء العجب من تتابع معظم تلك الانتصارات في شهر رجب. فمن رجب الإسراء والمعراج، إلى رجب تبوك التي انتصر فيها القائد المصطفى ﷺ على جيوش الروم المحتلة للمسجد الأقصى، وكانت هذه آخر غزواته ﷺ.
وما إن لحق رسولنا ﷺ بالرفيق الأعلى حتى حمل قادة الإسلام رايته واستكملوا وصيته مستأنفين فتوح الشام: الأردن وفلسطين، ثم الانتصار على الروم في معركة بيسان التي توجه بعدها سيف الله خالد وأمين الأمة أبو عبيدة إلى دمشق ففتحوها معلنين سقوط هرقل وعهد الطغيان الرومي في رجب سنة 14هـ.
وهكذا شهدت أيام رجب كل خير ونقلت المسلمين من نصر إلى نصر، وأزاحت معاركه طاغية وراء طاغية، فمن الروم إلى الأندلس حيث أوقفت معركة الزلاقة زحف الممالك النصرانية في شبه الجزيرة الإيبيرية بقيادة القائد الفذ يوسف بن تاشفين في رجب سنة 479ه.
ومع كل انتصار للمسلمين تلمع أسماءٌ لقادة جدد وأبطال تلو أبطال. هذا هو تاريخ أمتنا المشرق، أمراء عدل يجعلون كل شهورنا انتصارات. خلفاء تلتحم الأمة وراءهم، وتَدَّرعُ بحصنهم متوكلة على القوي المتين، هذا الالتحام بين الأمة وقادتها وذلك الاعتصام المبارك بحبل الله بين الحاكم والمحكوم هو سر القوة الحصينة التي كانت تميز الجيش الإسلامي فتجعله مؤيدا بالملائكة وبحول الله تعالى فيحقق الأعاجيب مهما كان قليل العدد والعدة.
تلك العقيدة القتالية هي التي كانت السر الذي يذهل الكفار ويذهل الكتَّاب والمؤرخين من شدة ما يعاينون مما لا عهد لهم به مع غير المسلمين. وكما صنعت الأمة تاريخا خالدا للانتصارات، فلقد منيت في تاريخها بنكبات كبرى، وضربات أوهنت جسدها وفرقت جمعتها، فاحتُلت فلسطين بعد تحريرها، وسقطت الأندلس بعد قرون من فتحها.
غير أن قدرة الأمة العجيبة على القيام، لا تنفك تذهل العدو والصديق. مهما ظن الأعداء أنهم أجهزوا عليها وأسكتوا أنفاسها، ومهما حسبوا أن أمتنا قد أذعنت وخضعت لجبروتهم، لا تلبث تلك الأماني أن تبددها صحوة الأمة بعد رقاد. فما أسرع أن تجتمع الأمة وراء قائد يستقطب طاقاتها ويوحد صفوفها من جديد.
نقرأ في تاريخنا عن التتار وظلمهم، والمغول ومجازرهم، لكننا لا نكاد نقلب الصفحة حتى نقرأ عن أبطال وقفوا ووقفت الأمة وراءهم من جديد. تجتمع الصفوف المسلمة وراء مظفر كقطز، أو ظاهر كبيبرس، أو سلطان كعبد الحميد...
نسمع أن المسجد الأقصى قد أسقطته حملات الصليبيين، وأن العقود تلو العقود قد توالت على أسره حتى ظن المحتل أن تسعين عاما من الاحتلال كافية أن تنسي الأمة أمانة الأقصى إلى الأبد. ثم لا تلبث هذه الأحلام أن تتبدد، ولا تلبث انتصارات رجب الكبرى أن تتجدد. يسأل الطغاة ما الذي جرى؟ فيفاجؤون برجب جديد والتحام للصفوف جديد وراء القائد الأيوبي صلاح الدين الذي دكت سنابك خيله أرض حطين، ثم تقدمت من انتصار إلى انتصار حتى وصلت بيت المقدس فحاصرت قائد الحامية الصليبية دانيال، ثم ما لبث فرسان الإسلام أن دخلوا المسجد الأقصى مكبرين مهللين محررين، وكان ذلك الفتح يوم الجمعة 27 رجب 583هـ الموافق 2 تشرين الأول/أكتوبر 1187م، وصلوا صلاة الجمعة الأولى في مصلى قبة الصخرة وراء قائدهم بعد 90 عاما من الاحتلال.
هذا هو الفارق الضخم بين ذلك الزمان وبين زماننا اليوم، بين رجبهم المنصور وبين رجبنا المقهور. واليوم تصيب أمتنا الأحزان وراء الأحزان؛ تشن عليها الحروب وتحاصرها الجيوش، ولكن لا يوجد صلاح يرد العدوان، ولا ابن تاشفين يجمع الطاقات ويستنفر القوى. من دون سلطان للإسلام، كل الأشهر سواء، وكل الأيام هباء!
لقد فرض الله على أمتنا التي وقف رسولها ﷺ إماما بالمرسلين، فرض عليها الريادة وحرم عليها الذل والخضوع، ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.
لقد كان شهر رجب شهر بركة ونور لأمة الإسلام، بدأت بركاته بهجرة المسلمين الأولى إلى الحبشة سنة خمس للبعثة حيث نقلت المسلمين من الخوف والملاحقة إلى الأمن والاستقرار، ولم تنته بركات رجب وخيراته إلا في ذلك اليوم الأسود الثامن والعشرين من رجب سنة 1342 حيث تم الإعلان الآثم عن إسقاط الخلافة الإسلامية وبدء العهد الجبري النكد الذي ما ذاق المسلمون فيه يوم راحة ولا عز ولا استقرار.
وإن بلادنا وأمتنا اليوم لتنتظر رجب خير جديداً، تتوّجه زنود دعاة راشدين، يعملون لإعادة الروح لهذا الجسد المبارك. لا ينقص أمتنا اليوم والتي علم العدو قبل الصديق أن صوت الإسلام الهادر في جنباتها لا يمكن أن توقفه الطائرات ولا الراجمات، لا ينقصها إلا أن يستجيب لهذا الصوت أنصار كعمر وأسعد وسعد بن معاذ، فإذا ما تم الزواج الميمون بين الرأي العام الإسلامي الواعي مع نصرة الأقوياء الأتقياء، فسيلد هذا الزواج قيادة راشدة، خلافة على منهاج النبوة، تحيل الأرض نورا وعدلا، وتعيد لأيامنا عزها ولتاريخنا انتصاراته وأمجاده بإذن الله تعالى.
بقلم: الأستاذ أحمد الصوفي



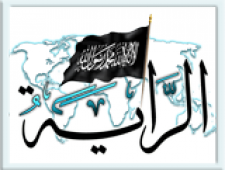

























رأيك في الموضوع