في الآونة الأخيرة تسارعت الأزمات الاقتصادية في مصر إلى حد لم تشهده البلاد من قبل في ظل أزمة سياسية وانقسام سياسي حاد وفي ظل أزمة اقتصادية عالمية وورطة سياسية لأمريكا في أماكن نفوذها مما جعل النظام الحاكم في مصر مرتبكا وفاقدا للاتزان، ونراه يتصرف بأيد مرتعشة ويتخبط في قراراته وينحدر بمستوى خطابه، والأزمات العالمية سياسية واقتصادية جعلت الأيادي التي كانت تمتد له في مثل تلك الظروف كي تدعمه تنقبض.
فأزمة الدولار التي تعيشها مصر الآن تمثل كارثة كبيرة للشعب المصري وتهدد النظام المصري وإمساكه بزمام الأمور؛ فبعد أن وعد الناس كثيرا في خطاباته المتفرقة بقوله (بكره تشوفوا مصر) ها هو الشعب يرى مصر تنهار أمامه، فالدولار الذي تعدى حدّ 11.5 جنيها في السوق السوداء ترتب عليه ارتفاع كبير في أسعار السلع بلغت 50 في المائة في كثير من السلع والخدمات، ناهيك عن الزيادة التي سبقتها بسبب رفع الدعم عن الوقود والسلع التموينية وإبدال ما كان يأخذه الناس من الدعم (زيت وسكر وغيرهما من سلع) بخمسة عشر جنيها للفرد يشتري بها ما شاء، ولكن بأسعار السوق، ثم تفقد هذه الخمسة عشر جنيها كثيرا من قيمتها على يد البنك المركزي الذي خفض سعر الجنيه رسميا كخطوة منه لعلاج أزمة الدولار، وتستمر الأزمة فتنخفض قيمة الجنيه أكثر وأكثر ويكتوي الناس بنار الغلاء أكثر وأكثر... ومن أمثلة هذا الغلاء زجاجة زيت ذرة سعة لتر كانت تباع بـ (14.5 جنيها) على مدار عام، ارتفعت بعد أزمة الدولار الأخيرة إلى (18 جنيها)، والأرز الذي تزرعه مصر بكثرة وتغطي بما تزرع حاجة الناس منه فتحت الحكومة باب تصديره للحصول على دولارات من الخارج فارتفع سعره المحلي لأسعار خيالية من (3.6 جنيها للكيلو إلى 6.5 للكيلو) مما أدى إلى احتقان داخل الشارع المصري بسبب هذا الغلاء الذي مس السلع الأساسية (وقود وأرز وزيت) وغير ذلك.
وأمام هذه الأزمة التي صنعها النظام بسبب تبعيته للغرب وأنظمته وقف حائرا وراح يرمي اللوم على الإخوان القابعين في سجونه وانطلق يعتقل من تبقى منهم خارجها من رجال الأعمال وراح يغلق مكاتب الصرافة مدعيا أنها وراء ارتفاع الدولار، فلم يفلح بذلك في حل الأزمة! هذا بالإضافة إلى نغمة الإرهاب التي يرددها كالببغاء خلف أمريكا والغرب الكافر، فكانت وبالاً عليه أن فقد مصدرا من مصادر الدولار ألا وهو السياحة، ناهيك عن اتهامه المستمر، كمن سبقه من الحكام، للشعب المصري بالتكاسل وعدم الوعي وغير ذلك من الاتهامات، وأضف لذلك الثقة التي فقدها الناس في ذلك النظام فهربوا ما معهم من مال إلى خارج البلاد، ومن كان منهم بالخارج أبقى على أمواله هناك، فوضع النظام نفسه في خانة ضيقة دفعته للقيام بعمل جنوني ألا وهو التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للنظام السعودي مقابل حفنة من الدولارات على أمل أن تخرجه من هذه الأزمة، وقابل ردة الفعل بارتجاف وتخبط في الفعل والقول؛ فأخذ يعتقل ويتوعد من يخالفه من الشعب بالسجن وغيره من صنوف العذاب... والجديد أنه توعد من يخالفه من ضباط الجيش والشرطة ولا ينفذ تعليماته بقوله (فلا يلومن إلا نفسه)!!
إن النظام في مصر كغيره من الأنظمة العميلة ينعق بما لا يسمع، قَبِلَ الذل والخنوع وراح يمليه ويفرضه على شعبه.
إن أزمة الدولار كغيرها من الأزمات ما هي إلا نتاج طبيعي لتطبيق النظام الرأسمالي؛ فالدولار ورقة تطبعها أمريكا وقتما شاءت وبالكمية التي تريد بتكلفة تكاد لا تذكر لأنها أصبحت ورقة عارية عن الذهب والفضة منذ عام 1971، ونحن نحصل عليها ببيع مقدرات شعوبنا ووصلت إلى بيع القوت والوقود... فها هي أمريكا تستحوذ على خيرات البلاد والعباد بورقة لا قيمة لها في ذاتها ولا تنوب عن شئ له قيمة، وها هم حكامنا يستخدمون كل آلات البطش والقهر كي يجبروا شعوبهم على التعامل بها وبذل ثرواتهم ومجهوداتهم للغرب الكافر هباء دون مقابل!! فأي حكام هؤلاء؟! وكلما شعر الناس بالجوع وقلة المؤنة انهال عليهم هؤلاء الحكام بالاتهام بالإرهاب والتخلف وأذاقوهم العذاب ألوانا؛ قتلاً وحبساً وغير ذلك.
إن تلك الأزمة التي تعيشها مصر لا حل لها إلا بنظام الخلافة التي تطبق الإسلام على الناس فتعيد نظام النقد الذي فقدته البشرية على يد الغرب الكافر، ألا وهو الذهب والفضة، فتحفظ على الناس ثرواتهم ومجهوداتهم وتعيد النظام الاقتصادي الإسلامي كاملا في ظل دولته؛ فيسعد المسلم والكافر في الدنيا وينعم المؤمنون بجنة ربهم في الآخرة.
إن الوضع في مصر يؤذن بانفجار شعبي وثورة عارمة يحسب النظام حسابها من بداية الأزمة ومن قبلها، وهذه الثورة التي لا محالة ستكون، وإن لم تكن لها قيادة على أساس فكري مبدئي فقد تؤدي إلى انكسارها من بدايتها والعودة إلى الوراء واستئساد النظام أكثر على الناس وزيادة بطشه، وإما إلى الفوضى والهرج واقتتال المسلمين بعضهم بعضا.
إن الحل الوحيد هو عودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، والطريق الوحيد لها هو أن يسلم الناس زمام المبادرة لحزب التحرير القادر بإذن الله على قيادة الأمة لبر الأمان.
بقلم: حامد عبد العزيز



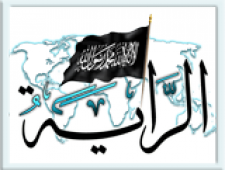

























رأيك في الموضوع