إن مقياس المعادلات السياسية الحالي في السياسة الدولية يستند إلى ميزان المصلحة والمنفعة المادية، هذا المقياس الذي كان ولا يزال يحمل في طياته مجموعة من المواصفات التي من شأنها أن تذيب أمامها جميع القيم الإنسانية والأخلاقية وحتى الروحية، أهمها أن المصلحة تكون فيه غير ثابتة وتتغير حسب الظروف والوقائع، فأصدقاء الأمس يمكن أن يصبحوا أعداء الغد عند انتهاء المصلحة والعكس صحيح، وشريك اليوم في عالم السياسة يمكن أن يتحول إلى سلعة للبيع في سوق النخاسة، وبالتالي فالعلاقة القائمة على أساس المصلحة هي علاقة مؤقتة تنتهي بانتهاء المصلحة، كما أن المصلحة، التي هي مقياس الأعمال السياسية، عرضةٌ للمساومة على مصالح أكبر منها؛ ما يجعل القضايا المصيرية عرضة للبيع على أيدي المقاولين، ولعل ثورة الشام مثال حي شاهد على ذلك.
ومن اللافت للنظر عند السياسيين المقاولين؛ قدرتهم على التلاعب والمراوغة، واستحلال الحرام وتحريم الحلال، وتمكنهم من التحول والتلون والتملص من مسؤولياتهم، واستعدادهم لحرف البوصلة وتغيير وجهة المركب ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا؛ وكلما وجدوا ذلك يحقق مصالحهم، مستندين في ذلك إلى قاعدة "الغاية تبرر الوسيلة"، وما تتضمنه من بطش ومكر وخداع، وكذب وتضليل وقلب للحقائق، ومستعدين لتبرير كل ذلك مستعينين بجيوش جرارة من السماسرة الطبالة، وفرق المرقعين المنتفعين، المستعدين لإلقاء المسؤولية على غيرهم وتبرئة المستثمر المتاجر في دماء الناس.
وهذا يقودنا إلى الحديث عن النظام التركي؛ ودوره في الثورة السورية، كواحد من التجار المستثمرين الأساسيين في تجارة الدم السوري، والذي ينطبق عليه ما تم ذكره آنفاً، فقد برع في المتاجرة بالثورة السورية على الصعيد الدولي؛ وعلى الصعيد الداخلي التركي، وحتى على صعيد آمال وآلام وأحلام أهل الشام. فقد استطاع النظام التركي خداع أهل الشام بتصريحاته الرنانة بداية انطلاقة ثورة الشام، من قبيل حلب خط أحمر، ولن نسمح بحماة ثانية، واستطاع أن يقنعهم أنه الحليف الاستراتيجي لثورتهم، والصديق الوفي لهم، وأنه الضامن الوحيد لانتصار الثورة؛ أو على الأقل عدم هزيمتها، فاستطاع بذلك ربط قيادات المنظومة الفصائلية ومصادرة قرارها، ودفعها إلى التخلي عن مساحات شاسعة من المناطق التي بذلت في سبيل تحريرها الدماء والمهج والأرواح، كما استطاع أن يدخلهم في نفق مفاوضات دولية طويلة الأمد، لا طائل منها سوى كسب الوقت لصالح طاغية الشام، واستطاع أن يسقطهم في فخ الهدن، وما نتج عنها من تهجير إلى شمال سوريا، كما استطاع أن يحول الكثير منهم إلى مرتزقة يقاتلون في أذربيجان وليبيا لمصلحة أمريكا، ويدافعون عن أمنه القومي على طول الحدود السورية التركية، مستنزفا في ذلك طاقات هائلة كانت من المفترض أن تصرف في إسقاط النظام السوري وإقامة حكم الإسلام، كل ذلك بات يدركه الجميع؛ ولكن ربما بعد فوات الأوان، فالمجتمع الدولي أعلن عن مناقصة إجهاض الثورة السورية منذ زمن بعيد، والنظام التركي يعمل على كسب هذه المناقصة وإجهاض الثورة بأبخس الأثمان، ليحقق من خلالها بعض المكاسب الشخصية؛ على مستوى أمنه القومي وبقائه في سدة الحكم.
ربما ينظر البعض إلى موقف النظام التركي الأخير من الثورة السورية؛ والذي عبر عنه وزير خارجيته جاويش أوغلو عندما دعا من أسماهم المعارضة إلى المصالحة مع طاغية الشام، ربما ينظر البعض إلى هذا الموقف على أنه قلب لظهر المجن، وتحول في السياسة التركية، وهذه النظرة بلا شك نظرة سطحية ساذجة، تدل على عدم الوعي على أبجديات السياسة الدولية، وعدم معرفة طريقتها وأساليبها وأدواتها ومقاييسها ووسائلها، فموقف النظام التركي لم يتغير منذ البداية، وجميع أفعاله تدل على ذلك، فحلب أصبحت خطاً أخضر منذ زمن، وتحولت جميع المدن السورية إلى حماة ثانية، وأصبح طاغية الشام صاحب سيادة على معظم الأراضي السورية يسعى أردوغان لعقد لقاء معه بعد أن كان مختارا لحي المهاجرين، وهو الآن يسعى لإنهاء عمله وإنجاز مهمته في إجهاض ثورة الشام وقبض الثمن على ذلك.
وخلاصة القول: إن تسليم قضايانا لغيرنا هو انتحار سياسي، لأننا نجعل بذلك من أنفسنا سلعة رخيصة تعرض في سوق النخاسة الدولي، ويبقينا ندور في دائرة الاستعباد لا نستطيع الخروج منها، وأقصى ما يمكن فعله فيها هو تحسين شروط العبودية بعد موافقة المالك الجديد.
وإن السير في طريق التحرر من الاستعباد، يقتضي منا العمل الجاد والدؤوب على استعادة القرار، وتحرير الإرادة كخطوة أولى. فالعبيد لا يملكون قرارهم، ويفتقدون إلى الإرادة المستقلة، "وثورتنا ليست ثورة عبيد" وإن من لا يملك قراره، لا يستطيع السير خطوة واحدة في الطريق الصحيح، مهما كانت أفكاره صائبة وحلوله ناجعة، لأن هذه الأفكار ستكون عاجزة عن الانتقال إلى حيز التنفيذ، بسبب افتقادها إلى صاحب القرار الذاتي والإرادة المستقلة، فمخزون الأسلحة الرهيب المكدس في المستودعات التي تسيطر عليها المنظومة الفصائلية المرتبطة، لن ينفع إن لم يوجد قرار لاستخدامه، وسيبقى حبيس الجدران يأكله الصدأ حتى يحين موعد تسليمه، والمجاهد الذي يقضي صيفه وشتاءه يرابط على خطوط التماس، سيتحول إلى هدف سهل لجنود طاغية الشام، دون أن يستطيع فتح جبهة واحدة، لأن ذلك يحتاج إلى قرار. وهذا ينطبق على جميع مقدرات الثورة ومقوماتها.
وحيث إن القرار بشقيه العسكري والسياسي يتمركز في القيادة وهي صاحبة الصلاحية فيه، وهي التي تنقله من الجانب النظري إلى الجانب العملي، كان لا بد من اتخاذ قيادة سياسية واعية ومخلصة، والسير خلفها في طريق التحرر من الاستعباد، فهي بمثابة العقل الواعي والمدبر، وهي من ستدير الدفة، وهي من ستتجنب المطبات السياسية والفخاخ والألغام المزروعة على جنبات الطريق، وهي من ستكون في المقدمة، ومعها البوصلة "المشروع السياسي" التي توجهها في طريق ثابت ومستقيم، بعيدا عن الارتجال والطرق الملتوية، فإذا توحدت الجهود الشعبية والعسكرية خلف هذه القيادة؛ كان النصر حليف أهل الشام في ثورتهم ضد طاغيتهم، واستطاعوا قطف ثمار تضحياتهم، والتحرر من ربقة الاستعمار بكافة أشكاله، واستطاعوا التحرر من أنظمة حكمه العميلة وتطبيق نظام الإسلام؛ بوصفه النظام الوحيد الرباني الذي يصلح البشرية جمعاء، قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا











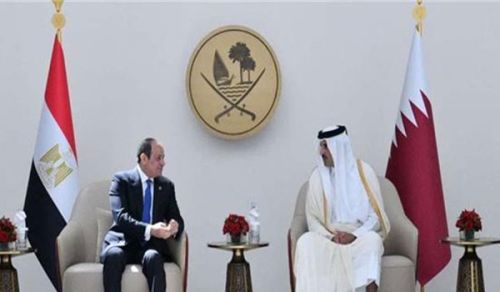

















رأيك في الموضوع