نشأت قضية فصل الدين عن الحياة عندما استفحل ظلم الكنيسة الممثلة للدين النصراني في أوروبا على الناس، فكان لا بد من مخرج لوقف هذا الظلم، فقام العلماء والمفكرون بالثورة على النظام الكنسي، وتفاعل الصراع بين الفريقين تفاعلا عدائيا أدى إلى إزهاق أرواح الملايين من الناس، وفق مصادر التاريخ عندهم. وانتهى هذا الصراع بالاتفاق على إبعاد السلطة الدينية عن رقاب الناس، واعتماد قاعدة فصل الدين عن الحياة، بناءً على فكرة الحل الوسط، وأن الإنسان هو الذي يضع نظامه بنفسه. ولم يعد منذئذ للقوانين الدينية أي أثر يُذكر في إدارة شؤون الدولة والمجتمع. وهذا القرار بالفصل بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية، رفع من قدر التشريعات الناتجة عن عقل الإنسان وهواه فوق التشريعات المنتسبة إلى الدين، وبمعنى آخر، تم قطع الصلة بين الخالق والمخلوق تعسفيا دون وجه حق، كونه تصرفا أحادي الجانب من جهة المخلوق! وكان الأجدر بهم أن يبحثوا عن علاقة أوثق وأفضل بين السماء والأرض، باعتبار أنهم لم ينكروا وجودها، وبالتالي اتباع مسيرة الأنبياء والرسل، والتي ستوصلهم حتما إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل بعد عيسى عليه السلام محمدا ﷺ بالرسالة الخالدة، لينظم علاقة الإنسان بنفسه وخالقه والآخرين، وجعله خاتم الأنبياء والرسل، حتى لا تقع البشرية في أي حيرة عقائدية وتشريعية بعد ذلك. ولكنهم بقرارهم التعسفي هذا قد تطاولوا على الدين، ورفعوا مقام العقل فوق مقام النقل، بل استخفوا بالنقل وعالم الغيب، واكتفوا بعالم الشهادة!
هذا وإن من أبرز مثالب هذه العقيدة التافهة والمضطربة (عقيدة فصل الدين عن الحياة) التي تتنافى وأبسط قواعد التفكير السليم، أنها عجزت عن الإجابة عن الأسئلة الثلاثة: من أين أتيت أيها الإنسان، ولماذا أنت موجود، وإلى أين ستذهب؟ وأخفقت في تقديم إجابات عليها تقنع العقل السوي وتوافق الفطرة السليمة، وبالتالي تملأ القلب طمأنينة، وبعجزها هذا فتحت الباب واسعا للنيل من الدين والمقدسات، باعتبارها من الموروثات التي تم تجاوزها بعد حسم الصراع، وبرروا لأنفسهم تخطي كل الخطوط الحمراء التي لا يجوز للمرء أن يتخطاها كي يحيا حياة طيبة في الدنيا، ويُقبل على خالقه بعد موته إقبالا كريما يوم القيامة.
ولما ضعفت مكانة الدين في النفوس، صار التطاول عليه سهلا ومأمون العواقب، فلا يعاقب عليه القانون الوضعي، ولا تنتصر له قوة ذات بال! بل أصبح المتدينون مواطنين من الدرجات الدنيا في المجتمع، وجرى العمل على تحقيرهم وإقصائهم عن المشاركة في الحياة، ونشأت قضية رجال الدين ورجال الدنيا، وفصل الحياة عن الكنيسة، والحريات الأربع، وغير ذلك من أمور يصعب حصرها في عجالة، ولكن أبرزها يكمن في إطلاق العنان للناس أن يشرعوا قوانينهم بأنفسهم من خلال ما بات يعرف بالديمقراطية وحكم الشعب للشعب بواسطة ممثلين عن الشعب.
هذا على صعيد الغرب ومن تبعه من شعوب الأرض من غير المسلمين، وأما المسلمون فكانوا - إلى حد ما - في مأمن من هذا البلاء، حتى حصل زلزال هدم دولتهم، دولة الخلافة العثمانية قبل قرن ونيف من الزمان، وسقطت مع سقوطها هيبة الدين الإسلامي في نفوس الكافرين، وعندها اجتاح طوفان الرأسمالية وعقيدة فصل الدين عن الحياة بلاد المسلمين، وتغلغلت في قوانينهم وأثرت على أنماط حياتهم وسلوكيات أفرادهم. وقد تجرأ بعض المسلمين المضبوعين بالثقافة الغربية على كثير من القيم الإسلامية، فكان تجرؤ الكفار عليها من باب أولى.
وقد أقيمت في بلاد المسلمين دويلات حكمتهم بغير ما أنزل الله، وتخلت عن نصرة قضاياهم بشكل فاضح، ووقفت عاجزة متخاذلة عن الرد على تطاولات المتطاولين على الدين والمقدسات والقيم الإسلامية الرفيعة، و"من أمن العقوبة أساء الأدب"! فكثرت جراء ذلك محاولات حرق نسخ من المصاحف، وشاعت قضية الرسومات المسيئة لشخص النبي محمد ﷺ، وكان آخرها تجرؤ الناطق باسم حزب باهارتيا جاناتا الهندي على مقام حضرة النبي ﷺ ووصفه بالمغتصب لقاصرة، في إشارة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأعظم من ذلك إذلال المسلمين ونهب ثرواتهم وقتلهم وطردهم من بلادهم وتشتيت شملهم، ولا عجب، فلا بواكي لهم بعد أن فقدوا الإمام الجنة الذي يتقى به ويقاتل من ورائه، وصدق فينا وفيهم قول الحق تبارك وتعالى: ﴿كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلّاً وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ﴾. ومنذ ذلك الوقت وديننا وقيمنا ومقدساتنا مستباحة يتطاول عليها كل صعلوك لكع ابن لكع من الكفار الحاقدين على الإسلام.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف نوقف هذه المهازل والتجاوزات الخطيرة؟ والجواب واحد لا ثاني له، وهو العمل على إقامة دولة للمسلمين كي تقوم بواجبها الشرعي في إقامة الدين، وإعادة الهيبة له، وضم الحياة مع الدين، بل لتسيّر الحياة بالدين، كما قال الله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾، هذا هو الاستحقاق الكبير اليوم لواجب وقف التجاوزات والتطاولات، وواجب تطبيق الشريعة كاملة في بلاد المسلمين، وواجب حمل دعوة الإسلام إلى العالمين رسالة هدى ونور عن طريق الجهاد في سبيل الله، لإخراج الناس جميعا من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغاً لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾.











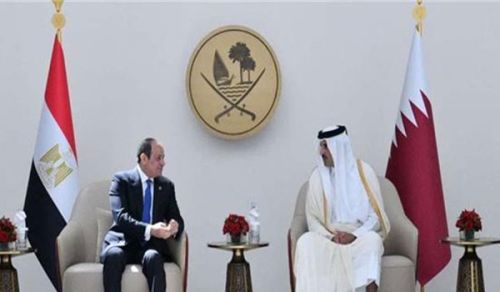

















رأيك في الموضوع