تلعب أمريكا قائدةُ الغرب الاستعماري اللعبةَ الخبيثةَ نفسَها في كل الأقطار التي تُمسك بها في بلاد المسلمين منذ عقود، وذلك كلما ارتفعت درجةُ حرارة الشارع واقترب ما في القِدْر من ذروة الغليان سخطاً على عملائها الذين خدموها أزمنةً طويلةً، أو ما زالوا في الخدمة يرعون نفوذها ومصالحَها بكل تفان وإذعان وإتقان، وأذاقوا شعوبَ هذه الأقطار كل أصناف الذلة والهوان والتعاسة وضنك المعيشة، بالقهر والقمع والتنكيل والبطش. ولا عجب، فهذا هو دور العملاء من أمثال عبد الناصر وحافظ الأسد وبشار وعمر البشير وفهد والسادات ومبارك وغيرهم. نقول هذا عن أمريكا من باب أنها الأقوى الآن نفوذاً، وإلا فإن دول أوروبا الاستعمارية هي الأخرى وعلى رأسها بريطانيا لا تقل خبثاً ومكراً، ولربما كان كيد الأوروبيين وجرمُ شياطين الإنجليز لصرف وحرف المسلمين عن دينهم أعظمَ في بعض البلاد كاليمن والجزائر وبلاد الحرمين وتونس والمغرب ودويلات الخليج وماليزيا والعراق وغيرها.
إلا أن ما بات يُزعج الغرب وينغص على أمريكا حقيقةً هذه الأيام هو أن لعبة العملاء أصبحت اليومَ مكشوفة مفضوحة. أما أنها تحكمُ بواسطة العسكر والأجهزة الأمنية والاستخبارات من وراء ستار، كما ظلت تفعل لعشرات السنين عبر حكام مصر والسودان وباكستان وسوريا ولبنان وإيران وغيرها، فإن هذا لم يعد مما يخفى على النخب في أوساط الشعوب، خصوصاً وأن هذه الشعوب بدأت تستيقظ الآن إن لم نقل إنها خطتْ خطواتٍ مهمةً على طريق النهضة. وعلامةُ ذلك تمردُها على حكامها الأجراء عند الغرب، أيّاً كانت تعبيراتها عن مطالبها، وأيّاً كانت التيارات والتوجهات الفكرية والسياسية فيها. المهم أنَّ الأمر بات مكشوفاً غير مستور، بحيث بات يقفز في كل مرة قادةُ الجيوش العملاء بصورة جلية إلى الواجهة كلما اشتد الخناق على الأنظمة العميلة حتى في "الجمهوريات الديمقراطية"! ذلك أن الأنظمةَ الحاكمةَ في جميع هذه الأقطار فاقدة للسند الشعبي وللشرعية بحكم التبعية والعمالةِ فضلاً عن البعد عن الإسلام، إذ هي مرتبطة بهذا الطرفِ أو ذاك من أعداء الأمةِ الإسلامية في الغرب.
بالتأكيد لم يعد هذا هو ما يخفى من اللعبة الاستعمارية. إن ما قد يُغطِّي على خبث أمريكا وإجرامها ومكرها لدى كثير من المسلمين اليوم إنما هو نجاحها ونجاح الغرب عموماً في جعل شريحة واسعة من أبناء الأمة نفسِها ممن يحملون ثقافةَ الغرب ونظرتَه ومقاييسه في الحياة خصوصاً العسكر، تقف في وجه الأمة كلما تحركت لتنعتق من هيمنته وقبضته، وكذا نجاحه في تمكينهم مادياً وسياسياً وأمنياً.
ذلك أن الأمة بفطرتها وبحكم الإسلام الكامن فيها، كلما دبت فيها اليقظةُ وتحركت في اتجاه التغيير من حالها كان الإسلام طبيعياً مطلبَها، وكانت العودة إلى الحكم الإسلامي وتطبيق الشريعة الإسلامية في حياتها مبتغاها، وإن لم تُفصح به نتيجة التضليل أو التعتيم أو سذاجة بعض أبنائها مغازلةً للغرب نفسه صاحبِ القوة، حتى وإن خرجت مطالبةً في الشعارات بالحرية والكرامة والديمقراطية. إلا أنها باتت في كل مرة تُؤتَى من داخلها في اللحظة التي يتحرك فيها الغربُ بواسطة أدواته وأتباعه فيها لمنع أي تحوِّل قد يُخرج البلد من التبعية، وهو دائماً ما يخلط الأوراقَ ويغيِّر في الظاهر من طبيعة الصراع ويغيِّر على الأرض منحى المواجهة، ويوجد بطبيعة التخطيط والحسابات السياسية الغربية حالةَ الاستقطاب الحاد المطلوبة غربياً في الشارع بين "العلمانيين" و"الإسلاميين"، مع أنهم جميعاً مسلمون وأبناء أمة واحدة!
وهو ما ينذر في كل مرة بمصير مجهول للبلد الثائر، يلوح به الغربُ الماكر دائماً على لسان أبواقه وعملائه عبر التهديد بخطر الاقتتالِ الداخلي أو الفتنة الطائفية أو خطرِ التقسيم والخراب أو تمزيق الوطن وضربِ الوحدة الوطنية أو حالةِ الحرب الأهلية أو غير ذلك من المآلات، خصوصاً إذا ما تحول الصراع بفعل سفارات وجواسيسِ الغرب، إلى عنف مادي دموي، كما هو مشاهد ملموس في كل البلاد العربية التي شهدت ثوراتٍ على أنظمة الغرب العميلة، وهو ما يوجد حتماً لدى عموم الشعب حالةً من الاستنكار والانكسار واليأس من التغيير الذي يبيت حينئذ ثمنُه باهظاً في نظرهم، ويصير لسان حالهم ينطق بالرغبة في التراجع والكف عن المطالب، وهذا هو بالضبط ما يريده الغرب الممسك باللعبة، للإبقاء على نفوذه وتمديد وجوده. وهذا هو ما سمعناه في كل البلدان الثائرة وما زلنا نسمع صداه اليومَ في كل من تونس وليبيا ومصر وسوريا والجزائر والسودان ولبنان وغيرها خصوصاً على ألسنة المضبوعين بثقافة الغرب والمرتبطين به مصلحياً بل وجودياً.
وخلاصة هذا المكر أن الناس في بلاد المسلمين - مسلمين وغير مسلمين - هُمْ في الهمِّ سواء، بعد ذهاب الدولة الإسلامية التي كانت لقرونٍ حاضنةَ الجميع. وكلما ساءت أحوالهم، فتحركوا طبيعياً وانتفضوا على الأوضاع التعيسة المزرية، استيقظوا ليجدوا خيوطَ اللعبة في يد الغرب المستعمِر بالكامل، خصوصاً وأن الغرب وهو يدرك مطلب الأمة الحقيقي، وهو مبدؤها أي الإسلام في حياتها، شرع منذ عقود في مغازلة من سماهم "المعتدلين" من أبناء الحركة الإسلامية لاستخدامهم في مآربه البغيضة، كما حدث في مصر مؤخراً، الذين ارتضوا التدرجَ المميت منهجاً، كما ارتضوا هم و"الليبراليون" الديمقراطيةَ الزائفة للعمل السياسي نهجاً وإطاراً، وأصبحت عندهم الدولة المدنية بَدَل الدولة الإسلامية مطلباً. فصاروا طبيعياً يستجْدون الغربَ ويستعطفون ما يسمى "المجتمع الدولي"، بل ويتطلعون إلى دعم الغرب لإيصالهم، وباتوا يحسبون لأمريكا ألفَ ألف حساب، لدرجة أنهم أصبحوا يُخفون الشعارات الإسلامية عن الساحات، ويُسقطون المعاني الشرعية من الألفاظ والعبارات، ويؤوِّلون النصوص لتوافق الغايات، معتمدين على رفع الأعلام الوطنية، وعلى الشرعية الشعبية وعلى وزن الأغلبية، بل ينشدون التغيير لأمتهم في رضا الغرب ضمن مصالحه هو في بلادهم.
لذا بات حزب التحرير - حاملُ لواء إعادة الخلافة من جديد - أخطرَ كيان سياسي في العالم خاصةً على أمريكا ممثلةِ الغرب الحاقد التي تحترف الإجرام وتحارب الإسلام، وكذا على الغرب الأوروبي وروسيا والصين، وبات هذا الحزب السياسي هو عدوَّها الأول، كما صرح بذلك غير واحد من ساستها ومفكريها. ولما كان الغرب الاستعماري يدرك جيداً أهمية الفكر المبدئي واليقظة الفكرية عموماً في تغيير أحوال الناس، وفي رسم مصائر الشعوب والأمم، عَمَدَ منذ بداية القرن الثامن عشر الميلادي، إلى نشر ثقافته السامة المميتة القائمة على مبدأ فصل الدين عن الحياة وعن الحكم والسياسة حتى استطاع أن يوجد من بين المسلمين من يحملها، وصار يعشق نمط الحياة الغربية، ولا يفكر في السياسة ولا في طريقة إدارة الشأن العام ورعاية أمور الناس إلا من الزاوية العلمانية التي تأبى أن يكون للدين أي دور في شؤون الدولة والمجتمع، ونسوا أن سرَّ قوة المسلمين إنما هو حصراً في إسلامهم.
إن الذين اعتمدوا في التغيير على رأي الأغلبية عبر الصناديق بدل نُصرة أهل القوة من أبناء جيوش الأمة، وعلى ما أسموه الشرعية الشعبية كما حدث مؤخراً في مصر وغيرها أملاً في الوصول تدريجياً إلى مراكز القرار، يبدو أنهم لم يتعلموا أقل ما يجب من السيرة النبوية العطِرة، وهو أن رسول الله ﷺ أمضى أكثر من عقد وهو يعالج عقول وقلوب الثلة المؤمنة معه، حتى غرس فيهم مفهومَ المفاصلة بين الحق والباطل والصبرَ على الطاعة مع الأخذ بالأسباب، والصبرَ على الأذى، والثباتَ على طريق الحق ومنهجِ الدعوة الرشيد ومنه طلب نُصرة أهل القوة والمنعة لإقامة كيان المسلمين، وعقيدةَ التوكل على الله التي قهَرَتْ وما زالت تقهر كل الطغاة والمجرمين. فيظهر من هذا جلياً أن هذا الذي تمكَّن من نفوس المؤمنين مع رسول الله ﷺ في مكة إلى جانب الفطنة السياسية واليقظة المبدئية التي أوجدهما القرآنُ في عقول الصحابة رضوان الله عليهم هو بالضبط ما أهَّلهم لنزول نصر الله عليهم والتمكين لهم في أرضه بعدما أذن الله لرسوله بالهجرة، وبقيام الدولة الإسلامية الأولى في المدينة.











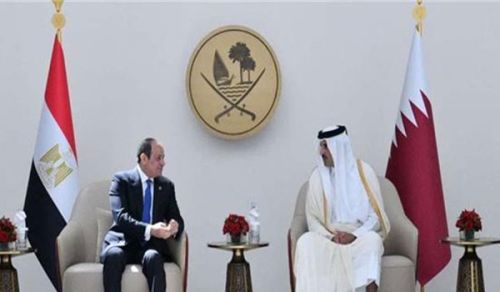

















رأيك في الموضوع