يعود الجدل حول علاقة العلم بالدّين ليطفو على السطح في كل مرّة يُستفز فيها أنصار العلمانية بتصريحات لعلماء مسلمين، تؤكد وجود الخالق أو تشير مجرد إشارة إلى أن العلم يمكن أن يكون طريقا لمعرفة الله، أو الإيمان به أو القرب منه. بل لقد أصبح الحديث عن وجود علاقة بين العلم والدين أمرا مثيرا لغيظ العلمانيين في تونس، وكأنهم أوصياء على علمانية الغرب، لا بل هم أشد دفاعا عنها وحرصا عليها!
فلقد أثارت مطلع هذا العام تصريحات أدلت بها مهندسة فضاء تونسية حول العلاقة بين الدين والعلم جدلا واسعا في البلاد. وجاءت التصريحات خلال برنامج تلفزيوني استضاف المهندسة رانية التوكابري، قالت فيه: "العلم يقرّبنا دوما من الله، وهناك أشياء كثيرة مذكورة في القرآن يكتشفها العلماء الآن". وأضافت: "من الأشياء التي تبهرني بالعلوم، خاصة عند قراءتي للقرآن، هي الآيات التي تتحدث عن الكون وحركة الشمس والقمر. كل هذا يجعلك أقرب إلى الله".
وقد قوبلت تصريحات المهندسة التونسية بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل، وأدت إلى انقسام حاد بين فريق رأى أنه يتعين على العلماء تجنب الحديث في الدين باعتبارها مسألة شخصية، وآخرون دافعوا عن حق التوكابري في التعبير عن رأيها.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل لقد حرصت الأبواق العلمانية على إثارة عديد المواضيع المتعلقة بجدلية العلاقة القائمة بين العلم والدين، ضمن سياق سياسي يستهدف الإسلام في أصوله وفروعه، تزامنا مع إزاحة الإسلاميين المعتدلين من الحكم، حيث تم التشكيك في عذاب القبر وفي صلاة الاستسقاء وفي غيرهما من الأحكام ضمن نظرة أحادية تتعسف على العلم والدين في آن واحد، حيث ترفض تناول موضوع نزول المطر مثلا تناولا دينيا ينطلق من العقيدة الإسلامية، لأن ذلك (حسب هذه النظرة) ضرب من ضروب الشعوذة التي ترفضها النظرة العلميّة للأمور.
أما إذا أثبت العلم، حقيقة كونية جاءت في الكتاب أو السنة، فإن ذلك سرعان ما يكشف حقيقة النفسية المهتزة وحالة التناقض الصارخ الذي يعيشه غلاة الثقافة العلمانية ودعاة التنوير الزائف.
هذا التناقض، متأت أساسا من نظرية المعرفة لدى الغرب، ونظرتها التعسفية للكون والإنسان والحياة نتيجة لفصل الدين عن الحياة. حيث إنها تسلطت على المعرفة من أجل اختطاف الطريقة العلمية عبر قولبتها بقوالب علمانية جاهزة ووضعها في صندوق معرفي خاص يحجبها عن العقل وعن استعمالها بشكل سليم لفهم الحقيقة.
فالأصل في العلم، أن يكون عالميا صالحا لكل البشر، وألا يتم احتكاره من جهة بعينها تخضعه لشروطها وأهوائها، فتقيد الإبداع باسم التنوير والحداثة. بهذه النظرة العالمية للعلم، انتشرت العلوم وتراكمت المعارف عبر العصور. ولكننا اليوم، صرنا أمام نظرة جديدة للعلم، تفرض عليه شروطا مسبقة، وترفض نتائجه إذا أوصل إلى فكرة أن وراء الكون والإنسان والحياة خالقا خلقها يستحق العبادة والشكر على نعمه.
نحن إذن أمام حالة من انفصام في الشخصية، تدعي العلم والمعرفة باسم العلمانية، ثم ترفض نتائجه إذا أوصل إلى حقيقة هذا الوجود. بل لا نغالي إن قلنا إن بعض العلمانيين في زماننا هذا، صاروا أقرب إلى الشعوذة والزندقة منه إلى العلم، حيث صاروا يستهلكون الأفكار الإلحادية ويستميتون في الدفاع عنها إلى حد التقديس تحت غطاء المعرفة العلمية حتى وإن اصطدمت مع مسلمات عقلية، مصداقا لقوله سبحانه: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى﴾. ولذلك، فإن العلم المشروط في الحقيقة ليس بعلم، إنما هو باب من أبواب الجهل المقدس والتخلف عن فهم حقيقة هذا الوجود.
أما في الإسلام، فالأمر مختلف تماما، حيث ينسجم تفكير المسلم مع عقيدته ودينه، ويزداد حجم هذا الانسجام كلما زاد المرء علما ومعرفة، بناء على قواعد عقلية قادرة على أن تحكم على المنهج العلمي، أي بناء على فهم حدود العقل بوصفه أداة للتفكير، ثم تنزيل هذا الفهم على جزئيات الكون والإنسان والحياة لإدراك هذا الوجود إدراكا يقينيّا. ثم على ضوء هذا الفهم اليقيني يمكن الاستزادة في المعرفة وطلب العلم الذي يجعل الإنسان يخشى ربّه كلما ازداد علما. قال تعالى: ﴿إنّما يخشى الله من عباده العلماء﴾.
فالقرآن هو كتاب الله المقروء، والكون هو كتاب الله المنظور، وكلّما ازداد الإنسان علما أدرك حجم التطابق بين كتاب الله المقروء وكتاب الله المنظور، ما يجعل رؤية المسلمين للمنهج العلمي رؤية متصالحة مع ذاتها، تتعامل مع الإنسان بوصفه إنسانا، ومع العلوم بوصفها أداة من أدوات فهم الوقائع المحسوسة والظواهر الفيزيائية المدروسة، وهي رؤية فريدة من نوعها، أساسها الفكر النهضوي الذي لا يمكن إلا أن يحدث ثورة علمية وصناعية تعقب الثورة الفكرية التي يحدثها الإسلام في نفوس حامليه، متى وجد للإسلام دولة وكيان ينفذ أحكامه.
بل لقد بدأ نزول الوحي بقوله تعالى ﴿اقْرَأْ﴾ إيذانا بميلاد أعظم مدرسة عرفها تاريخ البشرية، هي المدرسة المحمديّة التي لا ينطق فيها النبي ﷺ عن الهوى. ثم ظل القرآن يخاطب العقول ويطلب التأمل والتدبر في الواقع المحسوس، ويقدم الطريقة العقلية على المنهج التجريبي الذي يعتمده البحث العلمي من أجل اكتساب المعرفة. قال تعالى: ﴿أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ * وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾.
وهكذا، فإن البشرية اليوم، هي في أشد الحاجة إلى قواعد فكرية لا تخضع لعقدة الصدام مع الدّين الناتجة عن صراع الفلاسفة مع رجال الدين في أوروبا، إنما هي قواعد عقلية تحكم على المنهج العلمي بكل موضوعية وتصلح لأي باحث علمي منصف ونزيه، كي تكون أداة له لإقامة جسر مع الطريقة العقلية للتدليل، والاهتداء إلى حقيقة هذا الوجود من خلال النظرة العلمية، عندها لا يمكن للعلم إلا أن يقرب صاحبه من الله.
هذه القواعد، لا يمكن تشييدها والعمل بها في ظل أنظمة تحارب البحث العلمي وتهمش أصحابه وتقتل الإبداع لتكريس واقع التبعية الفكرية والسياسية للغرب، ولا في ظل الأنظمة الغربية التي تحتكر العلوم ونتائجها وتضع شروط الملكية الفكرية خدمة لأرباب الرأسمالية، بل ستعمل دولة الخلافة القادمة قريبا بإذن الله، على تبنيها من باب المسؤولية والحرص على مستقبل البشرية وإنقاذها من تغول الحضارة الرأسمالية المتوحشة.











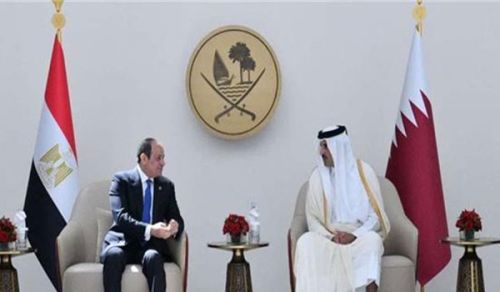

















رأيك في الموضوع