في خضم ما تشهده الجزائر في هذه الآونة من صراع وتفاعلات على أثر عودة بعض الرؤوس من أزلام فرنسا البارزين بعد إقصائهم وملاحقتهم بتهمة التآمر على سلطة الدولة، وما نجم عن تطبيع المغرب العلني مع كيان يهود وردود أفعال ذلك في الجزائر، وبالنظر إلى أن الجهة الممسكة بالسلطة في البلد لا تزال هي نفسها ممثلةً في قيادة أركان الجيش، ثم بالنظر إلى عدة أمور منها:
١- الحراك الشعبي وما تمخض عنه من حالة عدم استقرارٍ داخلياً، والذي كان للفريق المقابل أي جماعة فرنسا الدور الأبرز في إشعاله وتأجيجه، بصرف النظر عن حجم التظاهر وزخم الاحتجاجات والحشود والجماهير من كافة الأطياف التي خرجت بعد ذلك إلى الشارع وصدحت في الحراك الذي انطلق في شهر شباط/فبراير ٢٠١٩م بشعارات متعددةٍ تُطالب في مجملها بالحرية والديمقراطية في "دولة مدنية غير عسكرية" ولكن غيرِ مبلورةِ المعاني ولا محددة الأهداف، فضلاً عن افتقار رافعي الشعارات من المحتجين في الشوارع إلى قياداتٍ واعية ظاهرة.
٢- الكيفية التي تم بها تحريك وتوظيف التيار "العروبي-الباديسي-النوفمبري" لإخماد الحراك بركوبه وتبني مطالبه بطريقة ذكية ثم توجيهه في الظاهر ضد استعمار الأمس، وهو ما أفضى سريعاً إلى امتصاص الغضب الشعبي أيام قائد أركان الجيش السابق الذي تصدر المشهد حينها، ثم المرور على عجلٍ إلى تنظيم مسرحية الانتخابات الرئاسية التي جاءت بالرئيس الحالي من الزمرة المتنفذة نفسها عبر انتخابات يوم ١٢/١٢/2019م.
٣- الظروف المحيطة بالبلد فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية (وهذا هو الأهم الآن) وما صاحبَ ذلك من ضغوط أمريكية على النظام الجزائري بواسطة أدواتها وما تمخض عنه من توتير للأجواء في المنطقة ومع المغرب بشكل خاص بسبب تطبيعها المعلن مع كيان يهود، ما يعني دخول الكيان المسخ ومَن وراءه، أي أمريكا على الخط، وما يمثله ذلك من تحدياتٍ كبيرة للسلطة القائمة وأخطارٍ جسيمة على النظام الجزائري من الجهة الغربية، كون الجزائر هي المعوَّل عليها أوروبياً في صد نفوذ أي منافسين دوليين على منطقة نفوذها. يُضاف إلى ذلك كون جل أهل الجزائر يرفضون أي خطوة في اتجاه التقارب مع كيان يهود.
٤- كون نفوذ الفريق التابع لفرنسا في الجزائر لم يتبخر خلال فترة الرئيس السابق بوتفليقة التي دامت عقدين من الزمن فضلاً عما سبقها رغم اختلاف العمالة، وأن فرنسا تمتلك إلى اليوم نفوذاً وعملاء في جميع الأوساط السياسية والاقتصادية والثقافية وفي الإدارة وبالأخص في الأجهزة الأمنية من أيام الجنرال محمد مدين (توفيق) الذي استلم الجهاز في ١٩٩٠م وظل على رأسه ربع قرن بتدبير من جنرالات فرنسا في الجيش الجزائري، فهو والجنرال خالد نزار وغيرهما يمسكون إلى اليوم بالكثير من الخيوط حتى بعد إبعادهم. فضلاً عن أن فرنسا نفسها تؤدي دوراً مهماً لبريطانيا في المنطقة بل ولكل الأوروبيين في هذا الصدد، فليس خفياً أن هؤلاء ينسقون فيما بينهم في مناطق مستعمراتهم بحسب ما تقتضيه مصالحهم.
كل هذه الأمور مجتمعةً جعلت الأوروبيين (بريطانيا وفرنسا) يسابقون الزمن في عملية إيجاد وتجسيد تفاهمات توافقية مبنية على المصالح واعتباراتٍ ذات أوجهٍ متعددة في أعلى هرم منظومة الحكم القائمة في الجزائر تُفضي سريعاً إلى تعزيز حالةِ الاستقرار محلياً ثم تفعيل دورِ النظام الجزائري عسكرياً وأمنياً على الساحة الإقليمية لمجابهة المستجدات على الصعيد الخارجي. وهو ما يستوجب أولاً إحكام القبضة الأمنية داخلياً خصوصاً في المرحلة المقبلة التي يُتوقع أن تكون جد حرجة سياسياً واقتصادياً وربما أمنياً أيضاً. وهو ما استدعى مد اليد للذين كانوا بالأمس القريب ممسكين بالأجهزة المعنية أو كانوا أجزاء منها طوال عقود، في لعبة توافقية في أعلى الهرم وفق تعليمات المستعمِر الأوروبي تمكِّن المنظومة القائمةَ من البقاء والاستمرار بوجوه جديدةٍ وأساليب جديدةٍ ونَفَسٍ جديد، ولكن بنفس الولاء لنفس الجهات.
ولهذا سوف نشهد قريباً على الأرجح الإفراجَ عمن تستدعي الحاجةُ إلى أدوارهم خصوصاً من الأمنيين والعسكريين بحسب ما تمليه الأوضاع بعد إسقاط تهم التآمر والفساد أو غير ذلك عنهم عقب محاكماتٍ شكلية مرتبة سلفاً، وطي صفحة ما فعله رئيس الأركان السابق أحمد قايد صالح في أوج الحراك الشعبي وفق مقتضيات تلك المرحلة مضطرّاً. وذلك بغرض منع أو على الأقل التحكم في أي تحركات شعبيةٍ قد يشهدها الشارع مستقبلاً، وهو ما يؤرق النظام في هذه الآونة، ولكن أيضاً من أجل التحكم في الوضع على الصعيد العسكري خارجياً أي في الجوار الإقليمي شرقاً وغرباً وجنوباً وفق ما تمليه مصالح الأوروبيين حصراً. وهو ما نراه يتجسد الآن على الأرض من خلال عودة بعض الرؤوس. والبقية من الفريق المناوئ للزمرة النافذة على الطريق.
أما مواصلة تحريك قضايا محاكماتٍ هنا وهناك ضد الكثير من المسئولين من رموز المرحلة السابقة الذين كانوا في الواجهة، فإن ذلك يمثل مسلسلاً طويلاً من تصفية حساباتٍ تقتضي إبعادَ الخصوم أو تنحيةَ الممقوتين شعبياً ولو مؤقتاً، كما تندرج ضمنه لعبةُ "الاستمرار في محاسبة الفاسدين من العصابة السابقة"، وذلك بغرض مواصلة إعطاء الانطباع بأن "الجزائر الجديدة" يجري الآن بكل عزم وحزمٍ تشييدها.
ولسوف تتم قريباً تهيئةُ الأجواء بعد عودة الرئيس تبون من رحلة علاجية في ألمانيا دامت زهاء شهرين؛ لإجراء انتخابات برلمانيةٍ بعد "طرز" قانون انتخابات جديدٍ سوف يجري على أساسه تجديدُ البرلمان بغرفتيه. وقد يتم في سياق ذلك صنع أحزاب تابعةٍ جديدة أو إبراز أخرى مطبِّلة ومأجورة، خصوصاً من المحسوبين على التيار الوطني الإسلامي الجاهزين دوماً لملء كراسي غرف خداع الشعوب والجاهزة للتوظيف في شرعنة وتبييض النظم المرتبطة بالأجنبي مقابل دراهم معدودة. ولكن ليس قبل المصادقة على الدستور الجديد الذي جرى تمريره عبر استفتاء يوم الفاتح من تشرين الثاني/نوفمبر 2020م والتوقيع على قانون المالية لعام 2021، اللذين كانا على مكتب الرئيس في انتظار عودته من ألمانيا.
أما مسألة غلق الحدود مع المغرب، فإن الخطوة هي بالتأكيد سياسية بحتة يستفيد منها الطرفان تجاه شعبيهما، وذلك بصرف الأنظار إلى عدو متربص خارجي، وهي بالتأكيد من إملاءات أصحاب القرار من وراء المتوسط. علماً أنها في الوقت نفسه ذاتُ اعتباراتٍ أخرى إلى جانب الخلاف المصطنع بشأن مسألة الصحراء الغربية، منها أن المستعمِر الغربي يمنع بكل حزم أيَّ تقارب بين الشعوب الإسلامية مطلقاً بل يكرس العداء بينها على أساس الوطنية حتى في المباريات الرياضية، وهو يعلم أكثر من أهل البلاد (للأسف) ما يمثله تلاحمُ الجزائر مع المغرب فضلاً عن جمع شمل شمال أفريقيا كله رسمياً وشعبياً من قوة ومن خطورةٍ على كافة الأصعدة على نفوذه.
نسأل الله العلي القدير أن يعجل بالفرَج وأن يجمع شمل هذه الأمة الكريمة مجدداً تحت راية الإسلام في ظل خلافةٍ راشدةٍ على منهاج النبوة.











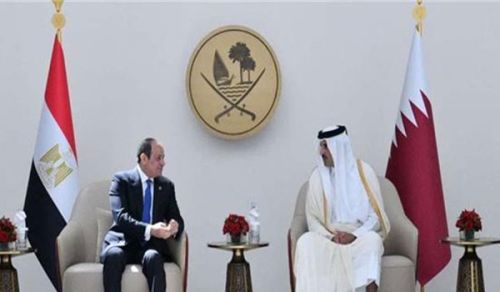

















رأيك في الموضوع