في مثل هذه الأيام من كل عام، نتذكر هدم صرح الإسلام وأفول شمس الإسلام، دولة الخلافة، في مثل هذه الأيام من كل عام نضيف سببا، وتارة أسباباً عديدة، توجب علينا نحن خير أمة أخرجت للناس وصْلَ ليلنا بنهارنا في العمل الجاد لإقامة الخلافة على منهاج النبوة التي بشّر بها وأمر بإقامتها رسول الله e حيث قال: «ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ».
إن الحكم بالإسلام وإيجاد الإسلام مطبقا في حياة المسلمين واجب شرعا، وهذا لا يكون إلا بتطبيق الإسلام سياسياً في دولة تتبنى الإسلام كنظام حكم، وهذه الدولة هي دولة الخلافة، ونظام حكمها هو الذي احتكمت به الأمة الإسلامية على مدار قرون مديدة من تاريخ الأمة، لقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾، وقوله عز وجل: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾، وظاهر جلياً في الآية الأولى أن الاحتكام يجب أن يكون لرب العزة، الله سبحانه وتعالى، خالق الكون والإنسان والحياة، وأمره ليس كأمر أي إنسان ولو كان ملكاً، مهما علا شأنه وامتد سلطانه، فهو أمر مالك الملوك وخالقهم، لذلك لا يُتصور التهاون في بذل كل غالٍ ونفيس لتلبية أمر الخالق الجبار وطاعته والسعي لإرضائه، خاصة وأن التهاون في ذلك وعدم التحاكم لشرع الله يضع علامة استفهام على إيمان المرء، كما جاء في الآية الثانية المذكورة أعلاه، ووضع إيمان المؤمن لإيمانه نحو المحك وصوب دائرة الشك وجوداً وعدماً يؤرق المؤمن ويجعله مضطرب الحال ليلا نهارا، فكيف يأمن المؤمن على مصيره أفي الجنة أم النار، والعياذ بالله، وإيمانه غير مكتمل سلفا قبل لقاء الله سبحانه وتعالى يوم الحساب؟! فالأمر جلل وليس بالهين على كل عاقل يؤمن بيوم الحساب وبالجنة والنار.
إنّ الحياة قصيرة، والذي هداه الله للإيمان لا يقبل أن يضيّعها في معصية الله، والتقصير في أداء واجبات الإسلام معصية، والمسلم يدرك أن عذاب الله لا يقوى عليه إنسان، بل لا يقوى على أقلّه، وهو جمرة من جمرات جهنم، حيث قال النبي e: «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ تُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ» (رواه البخاري)، وهذا هو أقل عقاب، فكيف بعقاب المخالفات الجسام، وعلى رأسها عدم تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، وهو الفرض الحافظ للفروض وتاجها؟! فرضٌ إذا لم يؤتَ على وجهه ضاعت باقي الفروض بسقوط تاجها... بالمقابل، فإن المسلم الذي هداه الله للإيمان ينير الله بصره وبصيرته إلى اغتنام فرصته في الحياة، فيستغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وطاعته عز وجل لا تتجزأ، بل تكون بالانتهاء عن جميع المحرمات، خاصة الكبائر منها، والقيام بكل الواجبات، والعظام منها، التي لا يقوم بها إلا من يريد أن يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله، فيكون يوم الحساب مع الأنبياء والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا، قال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾. بل إن المؤمن لا يقبل إلا أن يكون في الصفوف الأمامية في العمل لإيجاد الإسلام في معترك الحياة، فقد كان النبي e والصحابة الكرام أول من أوجدوا الإسلام في الحكم فكان لهم الأجر العظيم، ومن جاءوا من بعدهم حيث غاب الإسلام وعملوا بما عمل به الرجال الرجال من الصحابة رضوان الله عليهم كان لهم أجر الصحابة وأكثر، كما جاء في الحديث الشريف: «إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّاماً الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ»، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَزَادَنِي غَيْرُ عُتْبَةَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ؟! قَالَ: «بَلْ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ» الترمذي. لقد كان الصحابة من السابقين المقربين، لذلك يجب أن نأخذ الأمر مأخذه الصحيح، ونحرص على أن نكون من القليل الذين يأتون في الآخرين، فنكون سواء في الأجر والمصير، جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ * فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ * وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾.
لا يُتصور أن تستوي السيئة والحسنة، كما لا يُتصور أن يتساوى جزاء السيئات مع الحسنات، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً﴾. وإذا كان من ينقذ حياة بشرية واحدة كمن ينقذ البشرية جمعاء عند الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن ينقذ البشرية جمعاء من ظلم المبادئ البشرية وبطشها الذي أشقى الناس جميعا؟! إنّ العمل لإيجاد الإسلام في معترك الحياة هو خير الأعمال التي يقوم بها المسلم بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وبذلك يفوز المسلم في الدارين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
إضافة إلى هذا الدافع العقدي الذي يوجب العمل الدؤوب لإقامة الخلافة، فإن هناك ألف سبب عملي يدفع الجنس البشري - وليس المسلمين فقط - إلى التحاكم إلى شرع الخالق سبحانه وتعالى، الذي يوجد العدل بينهم ويحقق لهم الرخاء والازدهار، وليس كما فعلت بهم الأنظمة العلمانية، حيث أوقعت العداوة بينهم وأشقتهم وجوّعتهم... وهذا هو التحدي الذي يواجه البشرية الآن، استبدال الإسلام كنظام حياة ونظام حكم وطراز عيش بالعلمانية، وطال الزمان أم قصر فإنه لن يكون أمام البشرية خيار سوى الإسلام ليحكم بينهم وهو قائم وظاهر على الدين كله، قال رسول الله e: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَوَى لِي الْأَرْضَ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا» (رواه أحمد).










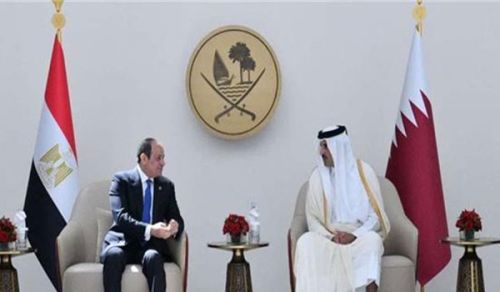

















رأيك في الموضوع