أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن برنامجي اليمين واليسار المتطرفين يؤديان إلى "حرب أهلية"، في حين دافع زعيم اليمين المتطرف جوردان بارديلا، الأوفر حظا في استطلاعات الرأي، عن جدية برنامجه وأكد "استعداده لحكم" فرنسا. وفي كلمة مطولة عبر برنامج بودكاست، شدد ماكرون لهجته حيال حزب التجمع الوطني الذي يقوده بارديلا وحزب فرنسا الأبية الذي يتزعم تيار اليسار الراديكالي. وقال "الحلول التي قدمها اليمين المتطرف تصنف الناس من حيث دينهم أو أصولهم، وهذا هو السبب في أنها تؤدي إلى الفرقة وإلى الحرب الأهلية". وبخصوص جبهة اليسار، قال "هناك أيضا حرب أهلية وراء ذلك، لأنك تصنف الناس فقط من حيث النظرة الدينية أو المجتمع الذي ينتمون إليه، وهي وسيلة لتبرير عزلهم عن المجتمع الوطني، وفي هذه الحالة، سيكون لديك حرب أهلية.. مع أولئك الذين لا يشاركونهم نفس القيم". (الجزيرة، 24/06/2024).
هذا الكلام الذي سوّق ضمنه ماكرون نفسه على أنه الحل الوسط، جاء عقب موجة صعود اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي، أين فتحت الديمقراطية الأوروبية أبوابها أمام أشد الناس قضماً للديمقراطية ونقضا لمبادئها تحت غطاء التمسك بالهوية الوطنية، لتزدهر الشعبوية والعنصرية في مناخ سياسي يشجع على استفحال ظاهرة الإقصاء "الديمقراطي" للآخرين، ذواتا وأفكارا وأديانا.
فقد أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث في عام 2023 أن نسبة كبيرة من الأوروبيين يعتقدون أن الهجرة تشكل تهديداً لهويتهم الوطنية. وخلال السنوات الخمس القادمة، سيهيمن هذا الفكر العنصري على العديد من دول أوروبا. وهو المركز الأمريكي نفسه الذي أقر منذ سنوات بأن الإسلام هو الدين الأسرع انتشارا في العالم.
وقد جاء حراك الشارع الأوروبي المتضامن مع غزة ليزيد من عمق الأزمة الحضارية التي يعيشها الغرب، ويدق ناقوس الخطر أمام الحكومات الأوروبية التي راحت تسابق الزمن في استهداف المسلمين أفرادا وجماعات، وتدفع برلماناتها نحو إقرار قوانين الحد من الهجرة، وفي مقدمتها البرلمان الفرنسي، بل راح وزير الداخلية، الذي منع (الحجاب) داخل المدارس، يُسخر أجهزة وزارته من أجل ملاحقة أئمة المساجد وترحيل عدد منهم إلى بلدانهم على خلفية خطابات مساندة لغزة، في حين كلف ماكرون اثنين من كبار موظفي الخدمة المدنية بتشكيل لجنة يرأسها الدبلوماسي المخضرم فرانسوا غوييت لإعداد تقرير حول الإسلام السياسي في فرنسا، وتقديمه في الخريف المقبل، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط المسلمة بفرنسا، كما قادت الحكومة الفرنسية حملة اعتقالات واسعة في صفوف المتضامنين مع غزة.
إذن نحن أمام حالة طوارئ سياسية وحضارية، تصاعدت فيها ظاهرة الإسلاموفوبيا بشكل غير مسبوق، واستنفرت فيها القوى العلمانية لخوض معركة وجودية ضد "أعداء الهوية"، وشعرت خلالها الدول الأوروبية، ومنها فرنسا، بتهديد جدي على تركيبة مجتمعاتها، حيث فتحت أبوابها للمسلمين لسرقة أدمغتهم ثم فشلت في احتوائهم ودمجهم سياسيا وثقافيا رغم ترويج أوهام التعايش، ما جرّعها مرارة الهزيمة النفسية وأوقعها في تناقضات صارخة تُقوّض أسس مبدئها القائم على الحريات.
في هذه الأجواء، لم يكن غريبا ولا مفاجئا تنامي التيارات اليمينية العنصرية داخل حاضنة سياسية وإعلامية رسمية وبيئة تحريضية ساهمت في صعودها كظاهرة فتحت أمامها المنابر والأبواق الدعائية، خاصة في فرنسا أم العلمانية، ومُصدّرة قيم الديمقراطية إلى باقي أرجاء أوروبا.
وهكذا ظلت فرنسا الاستعمارية المجاهرة بعدائها للإسلام دينا ولمحمد ﷺ نبيا ورسولا، تربة خصبة لإنبات اليمين المتطرف، ولانتعاش الأيديولوجيات العدوانية والنزعة القومية العنصرية والشمولية المتطرفة، واستحضارها واستجلابها من التاريخ الدموي والاستئصالي لنابليون وديغول مع تغليف ذلك الحقد الصليبي الدفين بصبغة شديدة الحداثة قائمة على تعقيدات العولمة والتكنولوجيات الذكية وتقنيات "التهديف الفردي السياسي" المشحونة بخطاب الكراهية مُضافة إلى تقنيات الاختلاق والاختراق لروايات مُهيمنة على مسارات كتابة تاريخ الأحداث الحالية، تنقلها وتروج لها بنبرة استعلائية وجوه شبابية تتقن فن الكلام وبيع الأوهام، لتنجح في خلق ظاهرة صوتية تعكس الحالة الهيستيرية التي صار يعيشها حماة الجمهورية، وتفضح دورهم في إتمام مهمة اختراق ذهنية الناخب الفرنسي الذي يئن تحت وطأة الضرائب والمحن الجبائية.
هذه هي فلسفة الأحزاب اليمينية في فرنسا، والتي يكاد ينحصر برنامجها السياسي في إيقاف نزيف الهجرة من البلدان غير الأوروبية وتعسير إجراءات الحصول على الجنسية الفرنسية، ليكون اليمين المتطرف الوجه الآخر للنظام الغربي الاستعماري. وهذه هي مقدمات فوز حزب التجمع الوطني اليميني بأكثر من الضعف على ائتلاف أنصار الرئيس في انتخابات البرلمان التي جرت في التاسع من حزيران/يونيو في فرنسا، وبروز ظاهرة جوردان بارديلا المثير للجدل تحت قيادة المتطرفة مارين لوبان التي دعت إلى وأد الثورة التونسية في مهدها زمن ساركوزي، ليضاف كلاهما إلى ورقة إيريك زمور ويعاضدا جهوده في منع أسلمة فرنسا، فيما أعلن ماكرون مباشرة عن حل الجمعية الوطنية (وهو البرلمان الفرنسي) وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة على جولتين، في الثلاثين من حزيران/يونيو والسابع من تموز/يوليو، بشكل بدا فيه أن قرار الحلّ جاهز بين يديه.
وبين اعتباره مقامرة أو مؤامرة، تباينت تفسيرات المتابعين والمحللين لهذا القرار، في انتظار نتائج الحسم الذي سيعقب تزوير إرادة الناخبين بتزوير عقولهم، حين تُختزل جميع مشاكلهم المتراكمة في مسألة الهجرة.
فرغم أن حل البرلمان كان خيارا مرفوضا عند ماكرون في وقت سابق لم يحصل فيه حزبه على أغلبية مطلقة، إلا أنه سارع اليوم إلى إخراجه من جعبته بشكل مفاجئ، دون أن يكون مجبرا على ذلك. وهذا قد يفسَّر بأمرين:
الأول: أنه يحتاج إلى مواجهة "الاختراق الإسلامي" لمجتمعه دون تحمل التبعات، خاصة وأن الإحصائيات تفيد بأن أكثر من أربعة آلاف فرنسي تركوا البلد بعد إسلامهم نتيجة المضايقات المتواصلة، وهذا التوجه المعادي للإسلام والمسلمين يشترك فيه مع بقية بلدان أوروبا بشكل متفاوت، وهي تحتاج من أجل تبرير مضايقاتها وتناقضاتها، إلى توظيف ورقة اليمين المتطرف خاصة في موضوع الهجرة والمهاجرين، دون أن يكون لهذه التيارات العنصرية تأثير فعلي على بقية الأهداف والسياسات الرسمية للاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها بلوغ هدف الناتو للإنفاق الدفاعي ليصل إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
والثاني: هو أمر متعلق بفرنسا على وجه الخصوص، وهو أن لوحة القيادة أمام رئيسها بعلاماتها الحمراء المشتعلة تقول إنه مُقدم على أصعب فترة في تاريخه، حيث تعتزم النقابات العمالية الدخول في إضرابات تزامنا مع الألعاب الأولمبية، وسط انسداد في الأفق على عديد المستويات، ولذلك تحجج ماكرون بنتائج الانتخابات الأخيرة، من أجل تقديم هدية مفخخة لمن سيشاركه الحكم في الداخل ويتقاسم معه أعباء الفشل الحكومي المتوقع.
وهكذا، قام ماكرون بمناورة سياسية مقصودة تستدرج اليمين المتطرف، ليمسك من جهته بعجلة القيادة ويوظف هذا التيار ككادم للصدمات، فيظهر الرئيس بمظهر الحمل الوديع، ويقدم نفسه بأنه المعتدل الحريص على الديمقراطية وقيم المواطنة، الرافض لتصنيف الناس على أساس الانتماء الديني والعرقي، معولا على ضعف الذاكرة ومتناسيا بأنه صاحب مقولة: "الإسلام يعيش أزمة". بينما يشغل اليمين المتطرف الشعب الفرنسي عن قضاياه الحقيقية بمسألة حرمان مزدوجي الجنسية من شغل "مناصب حساسة للغاية" وإثارة مواضيع الهوية، كمقدمة لحرب أهلية نظّر لها إيريك زمور في وقت سابق، ويساوم بها ماكرون شعبه اليوم لغايات انتخابية رخيصة.
لقد وجد ماكرون نفسه أمام أزمة سياسية خانقة ووضعية اقتصادية صعبة واستقرار مالي مهدد وترقيم سيادي متراجع، حيث ارتفع الدين العام لـ110.7% من إجمالي الناتج الداخلي وتباطأ انخفاض التضخم بسبب أسعار الغذاء فيما خفضت وكالة التصنيف ستاندرد أند بورز، تصنيف فرنسا الائتماني للمرة الأولى منذ عام 2013، مشيرة إلى تدهور وضع موازنة البلاد. (مونت مارلو الدولية، 02/06/2024). بل إن المفوضية الأوروبية قد بدأت بالفعل مباشرة إجراءات تأديبية ضد فرنسا وست دول أخرى، بحكم الديون المرتفعة التي وصلت إلى حد العجز المفرط.
وهكذا تقول كل المؤشرات إن بركان الغضب الشعبي في فرنسا، لا يزال نشطا منبئاً بحمم بركانية جديدة تضاف إلى احتجاجات السترات الصفراء ومظاهرات قانون التقاعد وانتفاضة الأحياء الشعبية التي أعقبت مقتل الشاب الجزائري نائل، وما رافق ذلك كله من عنف سياسي أدى بدوره إلى احتجاجات كبيرة ضد "عنف الشرطة"، هذا دون الحديث عن الحركات الانفصالية في كورسيكا وكاليدونيا الجديدة، وأثرها على بقية أقاليم ما وراء البحار، وجميعها أحداث سياسية غير مسبوقة في تاريخ فرنسا، يضاف إليها عدد من الانقلابات العسكرية في الساحل الأفريقي سحبت البساط من تحت أقدامها.
ولما أصبح ماكرون عنوانا للأزمة محليا ودوليا، صار يستعين باليمين المتطرف في الداخل ويغازل أمريكا في الخارج، عسى أن يمنع اندلاع حرب أهلية في بلده، سيكتب التاريخ أنه من أشعل فتيلها بسبب سياساته المجحفة، وإن استمات نظامه في إقناع الناس بأن الهجرة هي سبب كل الأزمات.
قال تعالى: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾. وقال سبحانه: ﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ﴾.











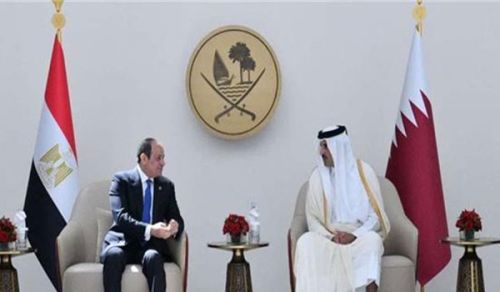

















رأيك في الموضوع