ارتضت بعض الحركات الإسلامية الانخراط في الأنظمة القائمة التي تحكم بغير الإسلام، والتي تتحكم فيها قوى محلية ودولية معادية للإسلام، وأشاعت بين المسلمين استناد مشروعهم إلى رؤية تعتمد الإصلاح الجزئي في منهج لين متدرج، يتجنب الصدام مع المجتمع أو القوى المؤثرة فيه، ويتخفف من أحمال النصوص الشرعية بتأويلها عند الحاجة من خلال التقريب بين الواقع والنصوص مسايرة للظروف فيما عرف بفقه الواقع وفقه المصالح، بل منهم من انغمس في الواقع حتى صار الواقع دينه وديدنه.
وقد تبنى هذا التيار، الملقب بـ(الوسطي أو المعتدل) عملياً العلمانية لكن بشكلها الملتحي، فغاية هؤلاء هي تقديم مشروعهم من خلال شعارات إسلامية براقة، من مثل (الإسلام هو الحل)، وهو شعار فضفاض أعلن من رفعوه عندما وصلوا إلى الحكم أنه كان مجرد شعار عاطفي لشحن الجماهير، ولذلك فقد تخلوا عنه عندما وصلوا للحكم، فهم يرون أنه لا داعي للحديث عن تطبيق الشريعة بشكل كامل، بل لا بد من التدرج في تطبيقها. وهذا يعني وبشكل واضح أنه لا مشكلة لديهم في تطبيق أحكام الكفر، ورغم أن انغماسهم البشع في الواقع بكل ما فيه من بُعد عن أحكام الإسلام، وتنازلهم عن مبدأ الإسلام، لم يشفع لهم عند الغرب وأذنابه، إلا أنهم ما زالوا يرفعون شعار المرحلية والوسطية والاعتدال!
ومما لا شك فيه أن القول أينما تكون المصلحة فثم شرع الله قد حظي عند جماعات الإسلام المعتدل أو الوسطي بمكانة خاصة وتم من خلاله تجاوز الكثير من النصوص الشرعية برغم وضوح كونه قولاً مغلوطاً، فالثابت عن أكثر أهل العلم أنه: (أينما يكون الشرع فثمة المصلحة) ذلك أنَّ الشرع وحده هو الذي يصلح لكل زمان ومكان وهو الذي يحدد المصلحة والمفسدة، فَمَن خلقنا قد جعل لنا نظام حياة نسير عليه، وهو أعلم بمصلحتنا وبما يصلحنا أكثر من أنفسنا، فينبغي أن تدور مصالحنا وعلاقاتنا ومجتمعاتنا حيثما دار الشرع، وليس العكس، كما يحاول من يتغطى بهذا القول، قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: 14].
إن بعض الذين انبروا للدفاع عن الإسلام وشريعته أمام هجمات الكفار الكثيرة، قد وقعوا في أخطاء جسيمة، أشنعها قبولهم أن يكون الإسلام متهما، مما جعلهم يقلبون الأمور رأساً على عقب. فرددوا تلك المقولة ولجأوا إلى التأويل البعيد، وإلى ابتداع العلل العقلية للنصوص الشرعية تمهيداً لإلغاء عمل بعض النصوص. فأباح بعضهم المشاركة في الأنظمة القائمة، وأباح بعضهم الربا، وأباح بعضهم الاستعانة بالكفار لقتال المسلمين، بل وجعلوا العقل حكما على الشرع، ففتحوا بذلك الباب على مصراعيه أمام من يريد الانحراف بالمسلمين تحت حجة المصلحة وتغير الزمان ومجاراة العصر. وبرغم ما أصاب دعاة الإسلام الوسطي المعتدل من ويلات نتيجة سيرهم في هذا الطريق، والذي تبين للقاصي والداني فشله ومخالفته لطريقة التغيير الصحيحة، إلا أن أصحاب هذا المنهج ما زالوا يصرون على المضي قدما في طريقهم، وما زالوا يحاولون التودد للغرب عله يقبلهم في لعبته الديمقراطية، ولنا فيما أقدم عليه حزب العدالة والتنمية المغربي الذي لطالما أكد في أدبياته على رفض التطبيع مع كيان يهود، واعتباره فعلا مدانا، خير مثال على حالة التردي والانحطاط التي وصل إليها أصحاب هذا المنهج، فقد فاق في تبريره للتطبيع مع كيان يهود أشد الحركات والأحزاب علمانية، فبأي مصلحة يتحجج هؤلاء وهم شركاء سوء وشهود زور لأنظمة العار؟!
يحتج هؤلاء بأن هناك أشياء وردت في القرآن الكريم لا نستطيع أن نعمل بها الآن؛ لأن العمل بها ضار بمصلحة المسلمين ولم يعد ملائماً لهذا العصر، ولم يبق له ما يُسوغه، فهم يزعمون أنَّ ما أمرت به الشريعة من قطع يد السارق ليس فيه مصلحة؛ بل صار مفسدة وسبَّة علينا، وصار الغرب ينتقدنا.
ومشكلة هؤلاء أنهم لم يفهموا الإسلام، وتمكنت الهزيمة النفسية أمام الغرب منهم، وقبلوا أن يكون الإسلام متهما، فانبروا يحللون ويحرمون على هواهم بحجة المصلحة وتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان. والحقيقة أن هذه الطريقة في التفكير هي طريقة مخالفة للإسلام، فهي تجعل الواقع مصدراً للحكم، بينما المصدر هو ما ثبت شرعاً أنه مصدر.
ومصادر الشريعة الإسلامية هي القرآن والسنة ليس غير، وأما أدلتها ففي القرآن والسنة وإجماع الصحابة والقياس الشرعي. والإسلام من خلال أنظمته يقدم تصوراً معيناً لما يجب أن يكون عليه الواقع، ولكيفية المعاملات والمعالجات والعلاقات. وحين النظر في الواقع فإننا نرجع إلى أحكام الإسلام لكي نعيد بناء الواقع والمجتمع على أساسها، فهي وحدها الرحمة وفيها المصلحة. أما أن ننظر إلى الواقع على علاته ونرضى به بناء على عقليات بشرية رأت أنه مصلحة ويُسْر، ثم نلجأ إلى النصوص الشرعية فنلوي أعناقها ونضع لها قيوداً ليست من الشريعة، فهذا لا يقره الإسلام ولا يرضى به. وعليه فإنه من الخطأ الفادح أن يقرر بعض العلماء اختيار الأيسر على اعتبار أن الدين يسر. بل الصحيح هو معرفة حكم الشريعة والالتزام به وبعد ذلك نقرر أن هذا الحكم هو اليسر. وفي هذا السياق يمكن فهم الحديث الذي روته عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنها: «مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ بِهَا لِلَّهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، فالتخيير بين يسرين يكون بين مباحين بدليل "ما لم يكن إثما".
فالحكم الشرعي هو ما يحقق المصلحة وإن كانت رؤيتنا البشرية عاجزة عن إدراك وجه المصلحة في ذلك الحكم. فالمفهوم الإسلامي الصحيح أن المسلم مأمور بالالتزام بأمر الله، وعليه ألا يحيد عنه، وأنه إذا التزمه كان في ذلك الصلاح والمصلحة ويتحقق بذلك اليسر والرحمة. ولا يضير في ذلك أن يعجز الإنسان أياً كان عن إدراك المصلحة في ذلك، قَالَ تَعَالَى: ﴿وِمَا كَانِ لِمُؤْمِنْ وَلَاَ مُؤْمِنَةِ إِذَاِ قَضَى اللَّهَ وَرَسُولِهُ أَمْرْا أَنَ يَكون لًهُمْ الْخِيَرَةً مِن أَمْرهم﴾ [الأحزاب: 36]. وليس للمجتهد أن يختار لنا حكماً بناء على ما يراه مصلحة، فهذا هو الحكم بالتشهي، بل يستنبط الحكم من بيان الشريعة التي هي تبيان لكل شيء.











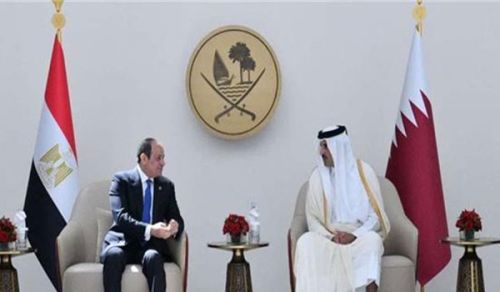

















رأيك في الموضوع