منذ أن استولى الجيش في مصر على السلطة في 23 تموز/يوليو 1952م، وحتى هذه اللحظة لم يكف رجال السلطة (الجيش) عن تنازع الثروات التي تحظى بها البلاد ونهبها نهبا مستمرا، فقد وضع الجيش يده بهدوء على الاقتصاد وأصبحنا نرى منظومة اقتصادية متكاملة يديرها الجيش بمعزل عن الدولة ولا يعرف عنها أحد شيئا وغير خاضعة لأي نوع من المراقبة لا من الجهاز المركزي للمحاسبات ولا من مجلس الشعب. حيث تناقش ميزانية الجيش من خلال مجلس دفاع وطني يضم كبار مسؤولي الدولة ومن بينهم الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع. ولا ينص الدستور على من له سلطة الموافقة على الميزانية. بل تم تهديد كل يد تمتد إلى تلك المنظومة بالبتر إن هي فكرت في التدخل في شأن تلك المنظومة. ولم يبق من منافس لها سوى حفنة من رجال الأعمال، لا يهمهم سوى تكديس الأموال في خزائنهم، والذي قد يكون مبررا لهم لسعيهم الدؤوب إما لتنازع تلك الثروات مع رجال العسكر، أو كسب رضا السلطة العسكرية علهم يظفرون بشيء من الفتات، وفي الحالتين الخاسر هم الناس الذين يعانون الفقر والحرمان.
بتوقيع اتفاقية السلام مع كيان يهود انتهى عصر الحرب في عرف النظام، ولم يعد التصنيع العسكري هدف الدولة الرئيس، برغم أن التصنيع العسكري ليس بالضرورة أن يرتبط بحالة الحرب، فهو طريق لقوة الدول من الناحية الصناعية الاقتصادية، وعنوان لنهضتها. وقد تزامن العزوف عن التصنيع العسكري الحقيقي مع برامج الانفتاح الاقتصادي التي بدأها الرئيس الأسبق محمد أنور السادات وأكملها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. ودخل الجيش المصري مضمار المنافسة في الاقتصاد المدني بشكل رسمي عبر القرار رقم 32 لسنة 1979 بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
في البداية صدر القرار بغرض تحقيق اكتفاء ذاتي للقوات المسلحة من السلع الغذائية والمدنية، وهو أمر لا بأس به، ولكنه تحول في عهد مبارك ومعه وزارة الإنتاج الحربي التي امتلكت شركاتها ومصانعها الخاصة تدريجياً كل شيء، عدا الصناعات العسكرية، تحول إلى منافس قوي للشركات الخاصة بعد أن بدأت موجة سياسة خصخصة الشركات العامة التي طالت الغالبية العظمى من القطاع العام المصري، بينما نجت إمبراطورية الإنتاج الحربي الجديدة التي تمتلك أكثر من 20 شركة ومصنعاً، لتبدأ سطور قصة مختلفة تماماً، شهدت انتقال قطاع كامل من صناعات عسكرية متقدمة كصناعة الصواريخ لمستوى متدنٍ لم يسبق له مثيل. بينما رأينا في المقابل تغولاً تاماً وسيطرة كاملة للجيش في الصناعات المدنية، مع ميزة كبيرة تفقدها الشركات المدنية المنافسة، تتمثل في الإعفاءات الضريبية وأيد عاملة رخيصة ممثلة في قطاع كبير من المجندين الذين يتلقون رواتب متدنية.
اعتبرت فترة ما بعد انقلاب الثالث من تموز/يوليو عام 2013م فترة ذهبية في تاريخ الشركات العاملة في حقل الإنتاج المدني التابعة للجيش المصري، وهي شركات كانت تعاني من انخفاض الإيرادات في فترات سابقة، إلا أنه وبعد الانقلاب العسكري توسعت الوزارة بشكل غير مسبوق لتصل توقعات إيرادات تشغيل شركاتها لقرابة 15 مليار جنيه مصري في 2018م، وهو ما يُعَدّ خمسة أضعاف ما كانت عليه في عام 2013م قبل صعود عبد الفتاح السيسي للحكم.
عندما تولى السيسي الحكم بدأ سياسة اعتماد شاملة على وزارة الإنتاج الحربي كأحد أبرز أركان إمبراطورية الاقتصاد العسكرية المصرية، بجانب الهيئة العربية للتصنيع وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع والمشروعات المدارة من جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعلى مر السنوات القليلة الفائتة رسخت الوزارة وضعها الاقتصادي بشكل أكبر، حتى أصدر السيسي القرار رقم ٢٤٤ لسنة ٢٠١٨م باعتبار الوزارة (من الجهات ذات الطبيعة الخاصة)، ولا تسري على وظائفها القيادية وإدارتها أحكام المادتين ١٧ و٢٠ من قانون الخدمة المدنية، اللتين تختصان بالتعيين في المناصب عبر إجراء مسابقات وعن طريق لجان محايدة، وبوجوب تحديد مدة معينة لشغل أي منصب حكومي.
لم تكتف الوزارة في عهد السيسي بتصغير بنية الصناعات العسكرية التاريخية لحدودها الأدنى مقابل توسع ضخم في إنتاج البضائع الاستهلاكية، بل أنشأت شركات جديدة ذات طبيعة مدنية خالصة، كما تم دعم الشركات العسكرية من خلال المصارف المملوكة من الدولة، وتوزيع العقود المرغوب فيها على شركات الضباط المتقاعدين بالأمر المباشر.
تبقى مشاريع البنية التحتية المجال الذي ينطوي على الإمكانيات الكبرى لمشاركة الجيش؛ فقد لجأ السيسي إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي كلفها بالإشراف على الفرع الجديد لقناة السويس وعلى إنشاء مئات الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، كما كلفها بتنفيذ البنية الأساسية للعاصمة الإدارية الجديدة. ناهيك عن الشركات التي تعمل في مجالات عدة أبرزها إنتاج المعكرونة والمياه المعدنية ومحطات وقود السيارات والطرق والجسور. وقد صدر مرسوم عن الحكومة، يقضي بتوسيع قدرة الوزراء على توقيع العقود أحادية المصدر، مما أدّى إلى انتقال أجزاء ضخمة من الاستثمار العام إلى الشركات العسكرية وشركائها، الذين مُنِحوا أيضاً عقود خدمات مهمة، بما في ذلك امتيازات طويلة الأمد لتشغيل بعض أكثر الطرق السريعة ازدحاماً في مصر وتحصيل رسوم استخدامها.
كما أصبح انتشار القادة العسكريين كبيراً جدّاً في أروقة الحكم. فسبعة عشر محافظاً من أصل سبعة وعشرين هم جنرالات عسكريون بالإضافة إلى ضابطَي شرطة من الرتبة نفسها، وسائر الحكّام المدنيين يتشاركون الحكم مع 24 لواءً في مناصب نائب المحافظ، والأمين العام، ومساعد الأمين العام.
بدأت هيمنة العسكر على قطاع الصحة في مصر بشكل مركز أثناء أزمة ألبان الأطفال عام 2016م، إذ قام الجيش المصري باستيراد ما يقارب 30 مليون عبوة حليب مدعياً رغبته في بيعها بأسعار أقل من السوق. كما تم تعيين القيادات العسكرية المتقاعدة كمساعدين لوزير الشئون المالية والإدارية بالتحديد، أي تمت السيطرة على الموازنة وكل موارد وزارة الصحة والتحكم في المشروعات والمناقصات والإنفاق.
ومما لا شك فيه أن وجود العسكر في المؤسسات المدنية يؤثر سلباً على وضع الموظفين من العامة، إذ يقلل نسبة حصولهم على ترقية أو تقدمهم في السلم الوظيفي ويشعرهم بأنهم موظفون من مرتبة متدنية وليس لهم الحق في الإدارة أو تحمل المسؤولية، كما أن الإدارة المباشرة لهذه الجهات تفرض شكلاً واحداً من طريقة تسيير العمل وهي إلقاء الأوامر بدون مناقشة، وتركيزهم على الجوانب التنظيمية فقط، هذا ما أدى بالعاملين في القطاع الصحي إلى شعور بأنهم يعملون داخل ثكنة عسكرية، ومجبرين على أداء مهامهم من دون رغبة حقيقية نابعة من إحساسهم بالواجب، مما عزز شعورهم بالاغتراب المهني.
إن مزاحمة إمبراطورية الضباط الاقتصادية للقطاع الخاص وطردها الاستثمارات الأجنبية، وهدر ثروات البلاد والأموال العامة، وغياب المنافسة الشريفة، وتهميش الكوادر والكفاءات المصرية يأخذ بالاقتصاد المصري إلى الحضيض، كما أنه يحد من الكفاءة القتالية للجيش وإشغاله بأمور ليست من مهامه التي يعرفها الجميع.











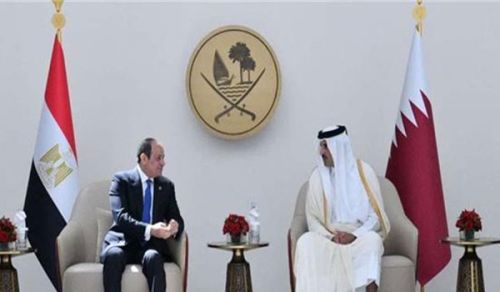

















رأيك في الموضوع