شهد عام 2016 أعلى عدد حوادث انتحار في تاريخ الأردن، ذهب ضحيتها 120 شخصاً وبارتفاع بلغت نسبته 6.1% مقارنة مع عام 2015،، وبمعدل حالة انتحار كل ثلاثة أيام، وتمت بطرق مختلفة منها إطلاق نار وحرق وشنق وشرب سموم وتناول كميات كبيرة من الأدوية والقفز عن مرتفعات، وسجلت منذ مطلع العام الحالي 2017 نحو 28 حالة انتحار خلال أول شهرين فقط.
ومن جهة ثانية فقد أظهر تقرير لجمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" ارتفاعاً كبيراً في جرائم الانتحار بين الأحداث بنسبة 100%، حيث ارتكبت 16 جريمة خلال عام 2016 مقابل 8 جرائم خلال عام 2015. وكان هنالك أيضاً ارتفاعٌ كبيرٌ في جرائم الانتحار المرتكبة من قبل الطلاب، حيث ارتكبت 18 جريمة انتحار عام 2016 مقابل 5 جرائم انتحار عام 2015 وبارتفاع وصل إلى 260%.
وتشير تقارير عام 2010 لمنظمة الصحة العالمية إلى أن نحو مليون شخص في العالم ينتحرون سنويًا، أي ما يعادل حالة انتحار واحدة كل 40 دقيقة، مما يرفع معدلات الانتحار بنسبة 60% في جميع أنحاء العالم عن الخمسين سنة الماضية، كما تتوقع الدراسة حدوث 1.53 مليون حالة انتحار في العالم عام 2020.
ولا تبدو هذه الوفيات تثير أي اهتمام أو تقصٍّ جدي لدى الدولة وأجهزتها في الأردن للحد منها ومعالجة أسبابها، ويقع جل الاهتمام بهذه الظاهرة على عاتق الجمعيات والمؤسسات التي يقوم عليها أفراد وجماعات والإعلام الرديف في لفت النظر، إثر غياب المسؤولية الرعوية للدولة، ويتم تناولها كظاهرة مرضية نفسية على الأغلب تعنى بها المؤسسات الصحية، وتتناولها بالتحليل والاستنتاج على هذا الأساس النفسي دون حلول عملية جذرية، وهي بذلك تتجنب البحث الحقيقي في الأسباب، عندما تختبئ وراء الأمراض النفسية لتبرر تزايد حالات الانتحار للأفراد المقدمين على الانتحار، تماما كما تبحثها منظمة الصحة العالمية، بدل البحث فيما وراء سوء الأحوال والأهوال التي يعاني منها الناس، والتي تؤدي إلى ضنك العيش وبروز الشعور المستدام من سوء الاستمرار في الحياة وعدم القدرة على تحمل أعبائها، فيلجأ الضعاف إلى إنهاء أو محاولة إنهاء حياتهم، فوراء كل حالة انتحار 10-20 محاولة انتحار لم تنجح.
فالإنسان بوصفه إنسانا إن لم يتوصل إلى معرفة غاية وجوده في هذه الحياة فإنه سيسير فيها وفق هوى النفس حيث توجهه أنماط العيش التي يحياها في مجتمعه، والتي تنشر سماته وأنماطه أجهزة الحكم، وتروج له في مجتمعاتنا كطراز عيش غربي عبر شتى المنابر الإعلامية ووسائل الاتصالات الحديثة، وليس حسب ما تقتضيه فطرة الإنسان بالرضا والقناعة، فالحضارة الغربية جعلت المادة إلهاً يُعبد، واعتزت بالفردية فجعلت الفرد مركز اهتمامها وأصبح هو يدور حول ذاته يقدسها، وهذا التركيز على الذات هو أساس لكل المشكلات النفسية.
بينما نجدُ أنَّ الإسلامَ بعقيدتهِ العقليةِ الموافقةِ لفطرةِ الإنسانِ وشريعتهِ التي نَظَّمَتْ ونَسَّقَتْ إشْباعَ جميعَ غرائزِ الإنسانِ وحاجاتِهِ دونَ إِغْفالِ أيٍّ مِنْها أَوْ إِطْلاقِ بَعْضِها على حسابِ بعضٍ، نجدُه قد حَقَّقَ بهذهِ العقيدةِ والشريعةِ السعادةَ والصحةَ النفسيةَ في نفوسِ مُعْتَنِقِيهِ، مستشعرين قول الرسول e: «من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا».
فعندما يتمكن الإنسان من إدراك حقيقة وجوده وأنه مخلوق لخالق سخّر له هذه الدنيا، يلتزم فيها بما فرضه الله عليه من أوامر ونواه، لتستقيم فيها حياته وحياة مجتمعه، فإنه لن يجعل منها أكبر همه، وهو سائر فيها يبتغي رضوانه، لأنّه على يقين بوجود حياة أخرى دائمة، سيبعث فيها ليحاسبه ربه على ما قدمت يداه، أما من يراها حياة واحدة ليس بعدها حياة فإنه لن يتوانى عن وضع نهاية لها إذا أحس بضيقها وضنكها فلا يرقب بعدها حياة.
فالانتحار ظاهرة غريبة عن المسلمين إذ لا يجوز للمسلم أن يضع حدّا لحياته وأن يقتل نفسه لأنّه على يقين أنّ الله سيعذّبه عذابا شديدا، ولأنه يعلم أنّه سيلقى ربه وسيوفيه جزاءه جهنم وبئس المصير، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي e قال: «من تردى من جبل فَقَتَلَ نفسه، فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تحسى سُمّاً فقتل نفسه، فسُمُّه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يَجَأُ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً».
إنّ المسلمين اليوم وإن تزايدت حالات الانتحار بينهم فإنها لا تعود إلى نظرتهم إلى الحياة التي علّمهم دينهم إياها، بل هي نتاج حضارة غربية دخيلة عليهم أفسدت حياتهم وصرفتهم عن دينهم وأضاعت هيبتهم وعزتهم، هذا هو السبب الجذري لهذه الظاهرة ولارتفاع نسبتها ارتفاعا كبيرا لافتاً، أي التصوّر الخاطئ لمعنى الحياة، ونظرة مغلوطة عقيمة عقم النظام الذي دعا لها عبر سنوات من الترويج الممنهج للأفكار والعقائد الدخيلة على طراز عيشنا الإسلامي منذ أن غابت عنه أحكام الإسلام وشريعته واستبدل بها مبدأ الحريات وفصل الدين عن الحياة، التي تجعل همَّ الناس نيل أكبر قسط من المتع الدنيوية بكافة أشكالها، فيصدم المرء عند سعيه ولهاثه وراء سراب لا يستطيع تحقيقه ولا يلزمه فيقع في صراع نفسي أو عاطفي يؤدي به إلى الاضطراب وبؤس الحياة، ووضع حدٍّ لها.
ويؤيد ذلك الدراسات وإحصائيات منظمة الصحة العالمية، التي تظهر انخفاض نسبة الانتحار في البلاد الإسلامية بشكل لافت للنظر، وخصوصا في حقبة النصف الثاني من القرن الماضي، أي منذ عام 1950 حتى عام 2000م حيث بدأت هذه الدراسات، بالرغم من غياب التشريع الإسلامي، وهيمنة النظام الرأسمالي بفساد نظامه الاقتصادي، ومن أبرز هذه الدراسات، دراسة تحت عنوان "وبائيات الانتحار من منظور عالمي" (Global perspective in the epidemiology of suicide, A) للباحثين، خوسيه مانويل بيرتولوتيه وأليكساندرا فلايشمان، من منظمة الصحة العالمية عام 2002، التي أظهرت انخفاض نسبة الانتحار لدى المتدينين بالمقارنة مع الملحدين، بل وأظهرت انخفاض نسبة الانتحار لدى المسلمين إلى حد قريب من الصفر مقارنة مع أصحاب الديانات الأخرى من النصارى والهندوس والبوذيين، كما يظهر الجدول التالي عدد حالات الانتحار لكل 100 ألف نسمة:
إن عدم رعاية الدولة لشؤون الناس، بأحكام الإسلام، هو الذي أوجد الظلم بدل العدل، والفقر بدل ضمان إشباع الحاجات الأساسية؛ من مأكل وملبس ومسكن وعلاج، وتعليم وأمن، وهو الذي أوجد الخوف بدل الطمأنينة والأمن، فغاب عدل الإسلام، وغابت أحكام الإسلام وأفكاره ومشاعره، وتحكمت في الناس غرائزُهم وأهواؤهم، فتتهيأ في نفسيات بعض شبابنا وسوسة تحدثهم بالإقدام على إنهاء حياتهم. كما يحدث في العالم نتيجة تحكم مبدأ فصل الدين عن الحياة على طراز العيش البشري الذي يؤدي للاضطراب النفسي والانتحار.
فسياسة الدولة في تغريب المجتمع هي السبب الرئيس وراء تعاظم حالات الانتحار في مجتمعاتنا فضياع نفس مسلمة واحدة هو كثير بحق الدولة، والعودة لمفاهيم العقيدة الإسلامية والقيم التي أرساها الإسلام هي التي تنقذ شبابنا من ضنك العيش والإحباط والاكتئاب النفسي، وذلك بتوفير أساسيات الحياة، وكمالياتها ما أمكن، وهذا لا يتحقق إلا بدولة الخلافة على منهاج النبوة، التي تحتاجها البشرية جمعاء وليس المسلمون فحسب، فما زال مليون إنسان يقتلون أنفسهم في العالم كل عام نتيجة فساد النظام الرأسمالي الغربي الذي يسود المعمورة، والذي يخلو من القيم، إلا النفعية المادية والتنافس على ملذات الحياة، والتي جعلت منها الأنظمة الحالية في بلاد المسلمين، هي الأساس.
فلو كان الإسلام مطبقا لجعلت أحكامه من النفس البشرية قيمة تحافظ عليها، فقد كانت الحياة الطيبة هي السائدة في المجتمع الإسلامي، فنتج عن ذلك الأمن والراحة النفسية والاستقرار والرقي في كل مجالات الحياة، أما في الدار الآخرة، فالمسلم يعلم أن حياته ستكون طيبة أيضاً في جنات عدن في مرضاة ربه جل جلاله في الأبدية التي لا تفنى ولا تنتهي. قال تعالى: ﴿قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾، فالحل الحقيقي والجذري لهذه المأساة، لا يكون إلا بعودة الإسلام تشريعاً ومنهجاً يسود العالم برحمته وعدله.
بقلم:د. أحمد حسونة
* نائب رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية الأردن



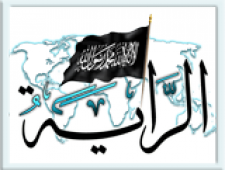







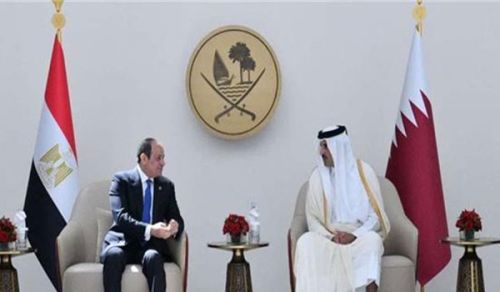

















رأيك في الموضوع