من المعروف بداهة أن قضية المسجد الأقصى هي قضية عقدية إسلامية، ولذلك لا يستقيم للحركات والفصائل العلمانية - التي تُنكر اتخاذ الإسلام حَكَما في الحياة وفي القضايا - أن تدّعي أنها قضيتها، ولا يمكن لها أن تستنفر ضد حرب التهويد (الديني) المتصاعدة التي يتحدى فيها كيان يهود المجرم أمة الإسلام وقرآنها، ولا أن تفهم خطورة مشروع التقسيم فيه بين اليهودية والإسلام.
هذا التناقض الفكري والثقافي بين حمل العلمانية وبين ادعاء حمل قضية المسجد الأقصى (الإسلامية) هو حقيقة سياسية شاخصة أمام الناس، مهما سمعنا من جعجعات "القيادات" العلمانية التي تجاهر، بل تفتخر بعلمانيتها، وتتنصل من أي التزام بالإسلام في الحياة السياسية. ومن هذا الباب لا يمكن لمنظمة التحرير ولا لأفراخها الفصائلية، أن تدّعي أنها تخوض نضالها للدفاع عن عقيدة المسلمين ومقدّساتهم، أو أن تعترف بالحرب الدينية حول المسجد الأقصى، مما يُعتبر ردة فكرية على عقيدتها العلمانية لو حصل! بل إنه لا قيمة روحية أو إسلامية للأحجار والمواقع في علمانيتها، ويتساوى عندها المسجد والكنيسة والكنيس، فكيف يُمكن فهم ذلك التباكي على المسجد الأقصى عند قادة المنظمة وفصائلها العلمانية؟!
ويزداد التناقض حدة، عندما تصدر تلك الادعاءات عن قيادات فصائلية يسارية، مثل الجبهة الديمقراطية، التي تشربت الفكر الماركسي الإلحادي، مهما حاول قياديّوها القفز على أفكارهم، ومحاولة الاقتراب من أفكار الناس ومشاعرهم الإسلامية، كما تحدث عضو المكتب السياسي فيها نهاد أبو غوش، في مقاله "ثغرات في جدار القدس"، نشرته "الحدث" وغيرها بتاريخ 8/8/2017، إذ حاول أن يلتصق بقضية المسجد الأقصى (الإسلامية التي تناقض الماركسية)، بينما حاول أن يحجب عنها أصحابها الحقيقيين، مدعيا أن "موضوع السيادة على القدس ومستقبلها ليس للشعب الفلسطيني سوى عنوان واحد شرعي ووحيد هو منظمة التحرير الفلسطينية".
إن السيادة على المسجد الأقصى هي للإسلام بنص قرآني وقرار رباني، لا يمكن أن تُبطله مرحلة هابطة في حياة المسلمين، تولّى فيها الحكام عن القدس، وأجبروا الجيوش على التخلي عن مسؤولياتهم في الجهاد لتحريرها، ثم حصروا قضية فلسطين في منظمة علمانية تستجدي التمويل والمواقف السياسية، وقد اعتنقت عقيدة "الحياة مفاوضات"، بديلا عن عقيدة الكفاح التي تفرضها العقيدة التي جعلت للمسجد الأقصى مكانته في وعي الأمة.
وإن قضية المسجد الأقصى وهويته، لم تكن ولن تكون كما وصفها الكاتب "العربية الفلسطينية"، هروبا من الإسلام المناقض للماركسية البائدة، وللعلمانية المترهلة، وإلا فالسؤال البسيط: ما علاقة صلاح الدين الكردي الذي حررها من الصليبيين، وما علاقة الأكراد من العائلات التي استوطنتها بعد التحرير بالقضية الوطنية أو العربية؟ ولعل السؤال الأكثر ألماً: ما علاقة العائلات التي قدمت من نجد - كعائلة الكاتب - وغيرها بالقضية "الوطنية"؟! لولا أن الإسلام هو الذي حركّهم، وصهرهم في بوتقة الأمة بعيدا عن الوطنية والقومية التي مزقت الأمة بسكين المستعمر.
بل إن بعض القيادات "الوطنية!" العلمانية تتجرأ بالتصريح، حول أحقية السيادة اليهودية على حائط البراق، متحدية سورة الإسراء، مما يفضح ارتباط "الوطنية" بإسلامية المسجد الأقصى المبارك، وهو ما سكت عنه الكاتب بينما وجّه سهامه نحو فئة من المرابطين، ممن نهضوا يؤكدون إسلامية القضية.
إن التناقض لدى الكاتب اليساري لا يقف عند حد الثقافة والفكر، بل يتعداه إلى المواقف من القيادة، فهو يتحدث عن "اتساع الفجوة بين جماهير شعبنا في القدس وبين القيادة"، وعن "فشل المؤسسة الفلسطينية الرسمية في تكريس مرجعية وطنية تشكل عنوانا موحدا للقدس والمقدسيين"، ثم يمتدح القيادة، بالقول: "الموقف القيادي الرسمي جاء بحق منسجما ومتكاملا مع الموقف الشعبي في القدس".
ولقد كان هذا التناقض والتمزق في فقرات المقال وأفكاره كفيلا بتركه دون تعقيب، لولا أن كاتبه تجرأ على المرابطين من أهل بيت المقدس، ونصّب نفسه حكما وقاضيا على أشخاصهم وانتماءاتهم، وراح يصرف صكوك الشرف ويكيل الاتهمات كما توسوس له نفسه، وتجرأ على وصف المرابطين من شباب حزب التحرير ممن كانوا في الصدارة، بما لا يليق أن يصدر عمن يعتبر نفسه يمثل "فصيلا فلسطينيا"، مع العلم أنك لو ذكرت اسم فصيله أمام أطفال فلسطين وشيوخها لما استحضروا في ذاكرتهم رجلا يرونه في الشارع والأحداث من ذلك الفصيل! ولعمري لا أدري إن كان فصيله - ذو الحصة في كعكة المنظمة - كله يمكن أن يملأ حافلة سياحية، كواحدة من الحافلات التي تنقل المرابطين للمسجد الأقصى!
ما كان لنا أن ننشغل به لولا أنه حاول بث دعاية باطلة، وادعى "وجود نعرة جهوية خطيرة"، وتقوّل أن تلك النعرة قد تدفع "البعض أن يزعم أن المقدسيين (وحدهم) هم من سلالة الأنبياء"، فيما يشبه الهذيان الذي لا صدى له على الأرض، ولم يدّعه أحد.
ثم كال الاتهامات الباطلة ضد حزب التحرير الذي يحمل قضية الخلافة، التي هي توأم قضية المسجد الأقصى، إن لم نقل أمّها، وقال: "ففي القدس يرتع حزب التحرير الإسلامي الذي مهما كان وجوده هامشيا في حياة الفلسطينيين إلا أنه يمتلك مواقع مؤثرة في المساجد وحلقات الدروس الدينية وخاصة في المسجد الأقصى"، ولا أدري كيف يصف حزب التحرير بالهامشي، وهو يُقر بحجم تأثيره في المساجد ومنها الأقصى! وكيف يمكن لعاقل أن يستخدم ذلك الوصف لحزب عالمي عابر للشعوب والقارات يقض مضاجع زعماء العالم وحكوماته! إلا أن حزب التحرير يستعلي عن وحل السلطة الأمنية والمنظمة العلمانية، ويرفض أن يتدنس بآثامها السياسية، ولعل هذا ما دفع الكاتب لذلك الوصف.
إن التخريب الذي مارسته قيادات المنظمة في المشروع الوطني الاستثماري قد طال المواقف وما خلفها من أفكار، وقد جعل ادعاء النضال مهنة للاسترزاق، ثم يدعي الكاتب أن الحزب "قادر على التخريب وتشويه الصورة والإساءة للوطنية الفلسطينية"... إن حزب التحرير أعلى شأنا وأرفع مكانة من أن ينشغل بهذه السخافات التي تسمى مقالات، ولكنها إذ تصدر عمن يوصف بالقيادي في الجبهة الديمقراطية - التي تقتات من كعكة المنظمة تحت دعوى النضال - فقد استوجب الرد لعلّه يوقظ من لديه بقية من وعي أو حس جمعي في ذلك الفصيل ليعيد توجيه أحد قيادييه، بما يلزمه وينبّهه حول الجريمة الثقافية في الاصطفاف مع المخابرات العالمية عند كيل التهم للحزب الذي يحمل همّ الأقصى كما يحمل همّ الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي توحد الأمة وتحرر البلاد من الأعداء والعملاء.
* عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين











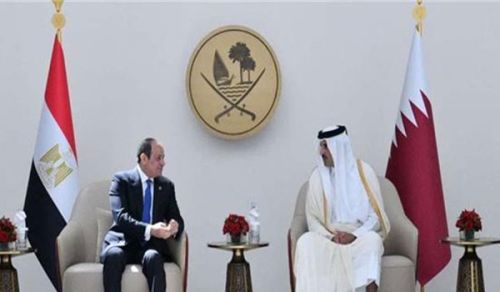

















رأيك في الموضوع