كانت النية أن أكتب لبيان تلبيس الغربيين على المسلمين بدس مشكل الأقليات، وكيف انطلى على كثيرين هذا المفهوم؛ فمنهم من اتخذه ذريعة لقبول سيادة العلمانية للحفاظ بزعمهم على أن لا تستبد الأكثرية المسلمة بالأقليات في بلاد المسلمين، ومنهم من انبرى للتأصيل لما يسمى فقه الأقليات ليوطن لاندماج المسلمين الذين يمثلون أقليات في المجتمعات الغربية في تلك المجتمعات فيذيبوا شخصياتهم الإسلامية وينسلوا من أحكام دينهم حكما فحكما، ولكني عدلت عن ذلك واخترت أن أكتب كيف أن الغرب اخترع مفهوم الأقليات فخّاً للأمة الإسلامية ليوغل من خلاله في مشاريعه الاستعمارية، ولكنه فخ كان الغرب نفسه أول ضحاياه.
قام الفكر الديمقراطي على مبدأ الأكثرية، فما رأته الأكثرية صوابا كان صوابا، ولكن المنظرين للديمقراطية اصطدموا داخليا بتسلط رأي الأكثرية على ما يسمى الأقلية، الأمر الذي تناقض مع ركيزة الحريات التي هي أصل الفقه التشريعي الغربي، لذلك احتاجوا لترقيع نظامهم الديمقراطي بمسحة ليبرالية، والليبرالية تقوم على حماية حقوق الأفراد والأقليات، فإذ يرى غالبية مجتمعهم أن الشذوذ أمر مقيت، فإنهم لحماية الأقلية الشاذة لا بد من تشريعه والترويج له (الليبرالية نقيض الديمقراطية)، فما رأته الأكثرية لم يعد مقدسا، بل يجب أن يعاد النظر فيه ليتماشى مع حقوق الأقليات، فماذا بقي من الديمقراطية إذن؟
واصطدموا داخليا وخارجيا بواقع عجز مبدئهم عن صهر الشعوب في بوتقة واحدة، خصوصا في ظل تدفق موجات الهجرة لمجتمعاتهم من مجموعات بشرية تحمل معتقدات لا توافق معتقداتهم، واتفق أنهم كانوا في حاجة لتثبيت غاياتهم الاستعمارية، فكرسوا مفهوم الأقليات، ونقضوا مبدأهم العلماني ثانية بجعلهم أساس الصراع بين الأقليات والأكثريات في خارج مجتمعاتهم على أنه هو حق الأقليات الديني والعرقي والتراثي في الوجود والعيش على أساسه، وهي تناقض الأساس العلماني للنظام الغربي القائم على التجرد المطلق والتحرر التام من القيم الناشئة عن الدين والتراث والأخلاق، فكونهم لجأوا لهذه المنطلقات ركيزة لتثبيت مبدئهم من خلال استعمالها فجوات للتدخل الاستعماري، فإنهم نقضوا أساس عقيدتهم للمرة الثانية بسبب فكرة الأقليات، وأما في مجتمعاتهم فكان العكس تماما، فعلى الأقليات أن تندمج أو تذوب في المجتمعات الغربية وتنصهر فيه وإلا فلا يحق لها أن تمارس أيا من شعائر دينها حتى ولو كان غطاء رأس! مما نقض أسسا كثيرة لمبدئهم مثل حرية الاعتقاد، والحريات الشخصية، فكانت مشكلة الأقليات مقتلا لمبدئهم.
وكانت الفاجعة الكبرى في فكرة الأقليات كونها تركز على إيجاد التناقضات في مجتمعات لم تكن تلتفت لتلك التناقضات، فتشحنها بالقلاقل والحروب والنزاعات، ومثال ذلك إشعالهم فتنة الشيعة والسنة، والأكراد والعرب، لا سيما وهم يبحثون عن مداخل ومبررات يلجون باستعمارهم منها، ليفرضوا علمانيتهم الديمقراطية بديلا عن الإسلام، فطرحوا مشكلا لم يكن قائما أبدا، وهو ما مصير الأقليات النصرانية، وأقل الأقليات ممن لا يبلغون أصابع اليد من العلمانيين والليبراليين والملحدين في بلاد المسلمين، وأمدوا تلك المجموعات البشرية التي سموها بالأقليات أحيانا بالمناصب وأخرى بالسلاح والسلطان، وكانوا يهيئونها لأن تسمى أقلية وأوجدوا لها الأحزاب القومية والوطنية، وصنعوا لها القادة العظام الملهمين! وأحيوا لها لغاتها التي ربما تكون ميتة وطوروها وخطوا خطوطها وأحرفها وقعدوا قواعدها، واختلقوا لها تراثاً ثقافياً وفلكلوراً أو رقصاً شعبياً كما يسمونه، وأبرزوا عاداتها وتقاليدها كأنها أعمالمقدسة، وأحيوا طقوسها الدينية، وكتبوا لها تاريخاً حافلاً بالأمجاد القومية! ومن ثم يقولون إن هذا الشعب شعب آخر يجب أن يأخذ استقلاله وهويته، فلزم أن تعطوه حق تقرير مصيره. لتبقى القلائل سيدة الموقف فيسهل عليهم التدخل والاستعمار، والتسلط والاستحمار. فمن أقليات دينية، كالنصارى والأزيديين، والصابئة، إلى أقليات قومية كالأمازيغ والأكراد، إلى غير ذلك من التجزئة التي يجعلونها مدخلا لغاياتهم الدنيئة وأغراضهم الاستعمارية الحقيرة، مما يثبت أن الحضارة الغربية إنما تقوم في أساسها على غاية الاستعمار وإثارة القلاقل وبث الحروب والنزاعات كي تجد لها موطئ قدم لنهب الخيرات وفرض السيطرة.
إن هذه النقائض للديمقراطية الغربية: الليبرالية داخليا، والأقليات داخليا وخارجيا، تكفي لبيان كيف أنهم نقضوا غزل مبدئهم بأنفسهم.
فالغرب إذن يبحث عن فوارق خاصة لدى مجموعات من الناس تكون مندمجة ومنسجمة مع غيرها في النظام العام في داخل مجتمع وفي ظل دولة واحدة، ولكنها أقل عدداً من غيرها، وفي كثير من الأحيان لا تكون لها أية مشاكل مع المجموعات البشرية الأخرى كما كانت الحال في ظل الدولة الإسلامية. وكل المجموعات البشرية كانت مندمجة في المجتمع الإسلامي بدون تمييز. وحتى بعد زوال الدولة الإسلامية وإيجاد هذه الدويلات الكرتونية الهزيلة بقيت هذه المجموعات البشرية منسجمة مع بعضها البعض؛ بسبب وجود آثار لأفكار الإسلام في قلوبهم وفي حياتهم. فمثلاً في تركيا حتى أعوام الثمانينات من القرن المنصرم لم يكن هناك مشكلة أقلية كردية ولم يكن يحس الأكراد بأنهم شعب آخر، بل كانوا منسجمين مع إخوانهم الأتراك ويعانون نفس المشاكل التي يعاني منها الأتراك؛ بسبب وجود نظام كفر فاسد يطبق عليهم يخالف دينهم. وكانوا يثورون لأجل نظام الإسلام كما حدث بثورة الشيخ سعيد الكردي من أجل إعادة الخلافة عام 1926م. ولكن في عام 1984م أسس الاستعمار عن طريق عملائه حزب العمال الكردستاني الذي بدأ بإثارة النعرة القومية عند الأكراد، وحدث ما حدث، وما زالت هذه المشكلة تتفاعل ودول الاستعمار الغربي تغذيها حتى تؤتي أكلها المر بفصل الأكراد عن الأتراك، وإيجاد كيان علماني آخر كما هو موجود في تركيا، فتزيد المشكلة تعقيداً.
من هنا فإن مفهوم الأقليات مفهوم مدمر مضلل للأمة، وهو مدخل استعماري خطير ينبغي محاربته فكرا وممارسة والعودة للعملية الصهرية التي صهر بها الإسلام كل الشعوب والأعراق في بوتقة قامت على أساس: لهم ما لنا من الإنصاف وعليهم ما علينا من الانتصاف.
كانت النية أن أكتب لبيان تلبيس الغربيين على المسلمين بدس مشكل الأقليات، وكيف انطلى على كثيرين هذا المفهوم؛ فمنهم من اتخذه ذريعة لقبول سيادة العلمانية للحفاظ بزعمهم على أن لا تستبد الأكثرية المسلمة بالأقليات في بلاد المسلمين، ومنهم من انبرى للتأصيل لما يسمى فقه الأقليات ليوطن لاندماج المسلمين الذين يمثلون أقليات في المجتمعات الغربية في تلك المجتمعات فيذيبوا شخصياتهم الإسلامية وينسلوا من أحكام دينهم حكما فحكما، ولكني عدلت عن ذلك واخترت أن أكتب كيف أن الغرب اخترع مفهوم الأقليات فخّاً للأمة الإسلامية ليوغل من خلاله في مشاريعه الاستعمارية، ولكنه فخ كان الغرب نفسه أول ضحاياه.
قام الفكر الديمقراطي على مبدأ الأكثرية، فما رأته الأكثرية صوابا كان صوابا، ولكن المنظرين للديمقراطية اصطدموا داخليا بتسلط رأي الأكثرية على ما يسمى الأقلية، الأمر الذي تناقض مع ركيزة الحريات التي هي أصل الفقه التشريعي الغربي، لذلك احتاجوا لترقيع نظامهم الديمقراطي بمسحة ليبرالية، والليبرالية تقوم على حماية حقوق الأفراد والأقليات، فإذ يرى غالبية مجتمعهم أن الشذوذ أمر مقيت، فإنهم لحماية الأقلية الشاذة لا بد من تشريعه والترويج له (الليبرالية نقيض الديمقراطية)، فما رأته الأكثرية لم يعد مقدسا، بل يجب أن يعاد النظر فيه ليتماشى مع حقوق الأقليات، فماذا بقي من الديمقراطية إذن؟
واصطدموا داخليا وخارجيا بواقع عجز مبدئهم عن صهر الشعوب في بوتقة واحدة، خصوصا في ظل تدفق موجات الهجرة لمجتمعاتهم من مجموعات بشرية تحمل معتقدات لا توافق معتقداتهم، واتفق أنهم كانوا في حاجة لتثبيت غاياتهم الاستعمارية، فكرسوا مفهوم الأقليات، ونقضوا مبدأهم العلماني ثانية بجعلهم أساس الصراع بين الأقليات والأكثريات في خارج مجتمعاتهم على أنه هو حق الأقليات الديني والعرقي والتراثي في الوجود والعيش على أساسه، وهي تناقض الأساس العلماني للنظام الغربي القائم على التجرد المطلق والتحرر التام من القيم الناشئة عن الدين والتراث والأخلاق، فكونهم لجأوا لهذه المنطلقات ركيزة لتثبيت مبدئهم من خلال استعمالها فجوات للتدخل الاستعماري، فإنهم نقضوا أساس عقيدتهم للمرة الثانية بسبب فكرة الأقليات، وأما في مجتمعاتهم فكان العكس تماما، فعلى الأقليات أن تندمج أو تذوب في المجتمعات الغربية وتنصهر فيه وإلا فلا يحق لها أن تمارس أيا من شعائر دينها حتى ولو كان غطاء رأس! مما نقض أسسا كثيرة لمبدئهم مثل حرية الاعتقاد، والحريات الشخصية، فكانت مشكلة الأقليات مقتلا لمبدئهم.
وكانت الفاجعة الكبرى في فكرة الأقليات كونها تركز على إيجاد التناقضات في مجتمعات لم تكن تلتفت لتلك التناقضات، فتشحنها بالقلاقل والحروب والنزاعات، ومثال ذلك إشعالهم فتنة الشيعة والسنة، والأكراد والعرب، لا سيما وهم يبحثون عن مداخل ومبررات يلجون باستعمارهم منها، ليفرضوا علمانيتهم الديمقراطية بديلا عن الإسلام، فطرحوا مشكلا لم يكن قائما أبدا، وهو ما مصير الأقليات النصرانية، وأقل الأقليات ممن لا يبلغون أصابع اليد من العلمانيين والليبراليين والملحدين في بلاد المسلمين، وأمدوا تلك المجموعات البشرية التي سموها بالأقليات أحيانا بالمناصب وأخرى بالسلاح والسلطان، وكانوا يهيئونها لأن تسمى أقلية وأوجدوا لها الأحزاب القومية والوطنية، وصنعوا لها القادة العظام الملهمين! وأحيوا لها لغاتها التي ربما تكون ميتة وطوروها وخطوا خطوطها وأحرفها وقعدوا قواعدها، واختلقوا لها تراثاً ثقافياً وفلكلوراً أو رقصاً شعبياً كما يسمونه، وأبرزوا عاداتها وتقاليدها كأنها أعمالمقدسة، وأحيوا طقوسها الدينية، وكتبوا لها تاريخاً حافلاً بالأمجاد القومية! ومن ثم يقولون إن هذا الشعب شعب آخر يجب أن يأخذ استقلاله وهويته، فلزم أن تعطوه حق تقرير مصيره. لتبقى القلائل سيدة الموقف فيسهل عليهم التدخل والاستعمار، والتسلط والاستحمار. فمن أقليات دينية، كالنصارى والأزيديين، والصابئة، إلى أقليات قومية كالأمازيغ والأكراد، إلى غير ذلك من التجزئة التي يجعلونها مدخلا لغاياتهم الدنيئة وأغراضهم الاستعمارية الحقيرة، مما يثبت أن الحضارة الغربية إنما تقوم في أساسها على غاية الاستعمار وإثارة القلاقل وبث الحروب والنزاعات كي تجد لها موطئ قدم لنهب الخيرات وفرض السيطرة.
إن هذه النقائض للديمقراطية الغربية: الليبرالية داخليا، والأقليات داخليا وخارجيا، تكفي لبيان كيف أنهم نقضوا غزل مبدئهم بأنفسهم.
فالغرب إذن يبحث عن فوارق خاصة لدى مجموعات من الناس تكون مندمجة ومنسجمة مع غيرها في النظام العام في داخل مجتمع وفي ظل دولة واحدة، ولكنها أقل عدداً من غيرها، وفي كثير من الأحيان لا تكون لها أية مشاكل مع المجموعات البشرية الأخرى كما كانت الحال في ظل الدولة الإسلامية. وكل المجموعات البشرية كانت مندمجة في المجتمع الإسلامي بدون تمييز. وحتى بعد زوال الدولة الإسلامية وإيجاد هذه الدويلات الكرتونية الهزيلة بقيت هذه المجموعات البشرية منسجمة مع بعضها البعض؛ بسبب وجود آثار لأفكار الإسلام في قلوبهم وفي حياتهم. فمثلاً في تركيا حتى أعوام الثمانينات من القرن المنصرم لم يكن هناك مشكلة أقلية كردية ولم يكن يحس الأكراد بأنهم شعب آخر، بل كانوا منسجمين مع إخوانهم الأتراك ويعانون نفس المشاكل التي يعاني منها الأتراك؛ بسبب وجود نظام كفر فاسد يطبق عليهم يخالف دينهم. وكانوا يثورون لأجل نظام الإسلام كما حدث بثورة الشيخ سعيد الكردي من أجل إعادة الخلافة عام 1926م. ولكن في عام 1984م أسس الاستعمار عن طريق عملائه حزب العمال الكردستاني الذي بدأ بإثارة النعرة القومية عند الأكراد، وحدث ما حدث، وما زالت هذه المشكلة تتفاعل ودول الاستعمار الغربي تغذيها حتى تؤتي أكلها المر بفصل الأكراد عن الأتراك، وإيجاد كيان علماني آخر كما هو موجود في تركيا، فتزيد المشكلة تعقيداً.
من هنا فإن مفهوم الأقليات مفهوم مدمر مضلل للأمة، وهو مدخل استعماري خطير ينبغي محاربته فكرا وممارسة والعودة للعملية الصهرية التي صهر بها الإسلام كل الشعوب والأعراق في بوتقة قامت على أساس: لهم ما لنا من الإنصاف وعليهم ما علينا من الانتصاف.











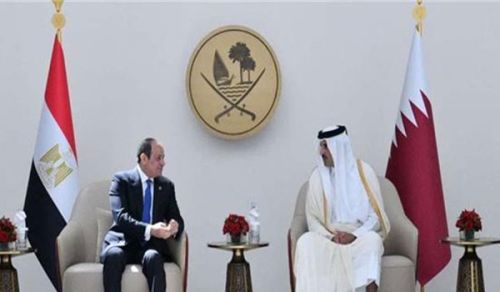

















رأيك في الموضوع