إثر فرار رأس السلطة والحالة الثورية التي عاشها الشعب في تونس وتداعي آثارها على سائر بلاد المسلمين بعد ثورة 2011، لم يكن أمام المستعمر الذي يمسك خيوط اللعبة السياسية في البلاد، إلا إرخاء الحبل للناس حتى لا يفلت الحكم من بين يديه خصوصا بعد بروز المطالبة الشعبية العارمة بتطبيق شرع الله، وقد تمكن من خلال الأحزاب والسياسيين والنقابيين الذين كانوا يؤثثون مشهد الحكم في زمني بورقيبة وبن علي، من إعادة صياغة الحياة السياسية بمجموعة من المراسيم المنظمة للحريات والحق في التنظم وصولا إلى إصدار دستور نوح فيلدمان في سنة 2014.
ثم عمل جاهدا بواسطة هؤلاء المجاميع من المستوطنين والمغتربين من خلال سياسة تشظية الحكم بينهم، وسياسات الارتهان إلى قرارات صندوق النهب والبنك الدولي التي فرضت عليهم كثمن لبقائهم على سدة الحكم، على مواصلة تنفيذ خطته الرامية إلى تفقير البلاد وتجويع الناس وإبعاد الأجيال الصاعدة عن هويتهم ودينهم بالتفعيل الواقعي عبر وسائل الإعلام والخطاب الثقافي لاتفاقية سيداو، ولكل مفاهيم الاستشراق والاغتراب عن الحضارة الإسلامية.
لقد استمر خدام الاستعمار في مخاتلة شعب تونس المسلم بكل صفاقة بالشعارات الزائفة كالحرية والعدل والمساواة والحق في العمل. وما كان لهذا النظام أن يستمر على حكم البلاد لولا استمرار المؤثثين لمشهد الحكم (وليسوا حكاما) بالأكل من الطاولة القذرة للغرب الصليبي الرأسمالي الذي ثبتهم في مناصبهم بحبل المؤامرات والاغتيالات وافتعال المناورات والسيطرة على الرأي العام تحت غلالة الظلام الإعلامي الكثيف والتضليل الذي تمارسه وسائل الإعلام، إلى أن تمكن في نهاية المطاف من القبض على مقاليد الحكم من جديد.
حالة القضاء في تونس قبل ثورة 2011
وفي تونس وكسائر بلدان العالم التي لها دستور ينظم الحياة السياسية على معنى الطراز الغربي الديمقراطي للحكم، لم يكن فيها القضاء في زمني بورقيبة وبن علي غير الآلة الباطشة للنظام بالمعارضين السياسيين، ففي مثل هذه البلاد التي اعتلى فيها الحكام سدة الحكم بتكوين دول علمانية، لم تكن لهم شرعية شعبية لأن ثمن وصولهم إلى الحكم كان محاربة الإسلام ومفاهيم الدولة، بحيث لم يكن في إمكانهم مسك زمام النظام إلا بالحديد والنار، فوقع استعمال القضاء إلى جانب البوليس كأحد الأدوات اللازمة لتنفيذ الحكم والسلطة.
حالة القضاء في تونس بعد ثورة 2011
ومن هذا المنطلق، احتدم الصراع بعد الثورة، بين السلطة السياسية الممثلة آنذاك في حركة النهضة وبين جمعية القضاة التونسيين حول مسألة استقلال القضاء، فكان مطلب القضاة هو أن تترأس النيابة العمومية (ممثلة الادعاء العام) نفسها بنفسها، تحت السلطة التنظيمية والتأديبية للمجلس الأعلى للقضاء، في حين كان موقف النظام هو بقاء النيابة مرؤوسة من وزير العدل، وفي نهاية المطاف أوجدا حلا وسطا بينهما، بأن يظل الادعاء العمومي مرؤوسا من وزير العدل، على أن يكون شخص رئيس النيابة العمومية في كل محكمة منتخبا من زملائه، وقد شهدت البلاد آنذاك طفرة من الأقضية المرجعية في الحقوق والحريات، ولعل أبرزها والتي يغيبها الإعلام، هي صدور قرار عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية يقضي بإيقاف تنفيذ قرار منع المؤتمر السنوي لحزب التحرير تحت شعار "الخلافة منقذة العالم"، وبالتالي السماح بعقد المؤتمر، إلا أن النظام امتنع عن تنفيذ القرار بضرب سياج على العاصمة واختطاف شباب الحزب في الطرقات ومن وسائل النقل.
والتاريخ هنا يشهد على تقاسم كعكة الحكم بين الفرقاء السياسيين بالشكل الذي أدى إلى انسداد أفق النظام في إدارة الدولة، غير أن ما يمكن ملاحظته، هو حفاظ الاستعمار على مستوطناته التي تمكنه من مراقبة الصحوة الإسلامية، حيث لم ينصب الثوار المحكمة الدستورية، ولم ينقحوا قوانين الطوارئ والتظاهر وأبقوا على المحكمة العسكرية واستعاضوا عن فرق أمن الدولة بفرق مقاومة الإرهاب وقطب مكافحة الإرهاب، وأصدروا قانون الإرهاب الذي يجعل من مجرد ذكر آيات الجهاد والقتال والكفر والطاغوت وغيرها من العبارات القرآنية والإسلامية تحت طائلة المحاكمة الجزائية. والقائمة على إفساد الحياة السياسية أطول من أن يقع حصرها في هذا المقال.
حالة القضاء في تونس بعد الانقلاب القانوني
باعتباره القبضة المباشرة لعقاب الناس وردعهم وإيقافهم، مثّل القضاء أحد العناصر التي عمل النظام على إعادتها إلى بيت الطاعة، فبعد تجميد مجلس النواب، ومن ثم حله، وإصدار المراسيم الفرعونية، تم عزل سبعة وخمسين قاضيا كانوا يمثلون الادعاء العام في تونس بناء على تقارير أمنية وبدون مراعاة لأبسط قواعد انعقاد الخصومة والدفاع، ثم تم تغيير الدستور الذي نزع عن القضاء صفة السلطة، وإثر ذلك تم تطويع قيادات النقابات العمالية، وحل النقابات الأمنية، وتدجين الإعلام بتهديد الفاعلين فيه بملفات فسادهم، ثم الزج بجميع قيادات المعارضة المباشرة للنظام - حكام الأمس - في السجن.
وبكل هذه الإجراءات وبمساندة القوة الصلبة، تمكنت السلطة من إعادة القضاء إلى بيت الطاعة، وتطويعه عبر تهديده بقطع الأرزاق والجوع، فانبرى قضاء الحق العام في تنفيذ التعليمات المباشرة وغير المباشرة بل بالتزيد في بعض القضايا (مثل القضايا المتعلقة بحزب التحرير وشبابه) تنفيذا لفروض الولاء والطاعة، وهكذا أصبح جميع التونسيين في حالة توقيف بالسجن مع تأجيل التنفيذ الذي قد يتسلط على أي واحد منهم بمجرد وشاية كيدية أو تأويل لمقولة.
خدعة استقلال القضاء في المبدأ الرأسمالي الديمقراطي
تجدر الإشارة إلى ضرورة التمييز بين عبارتي استقلال واستقلالية، ذلك أن رجال القانون يستعملون عبارة استقلالية القضاء ولا يستعملون استقلال القضاء، لأن الاستقلال يعني الانفصال التام والكلي عن النظام، ذلك أن أسوأ فكرة تؤرق حتى أعرق الديمقراطيات هي فكرة دولة القضاة، هذا بالإضافة إلى أن القاضي في هذه الأنظمة يطبق القوانين التي تضعها السلطة الحاكمة ولا يمكنه البتة الخروج عنها وإلا توجه له تهمة "نكران العدالة".
ومن هنا، وإذا كان من الممكن وجود مفهوم استقلال القضاء في الواقع، فلا يمكن أن ينطبق إلا على القاضي في دولة الخلافة، ذلك أنه الوحيد الذي لا يخضع لا لحاكم ولا لمحكوم ولا لقانون مهما علت درجته، فلا سلطان عليه إلا من خالق الحاكم والمحكوم، فلا سلطان على أحكامه من أية جهة، وإنما السلطان الوحيد يكون للشرع وللمهمة الموكولة إليه وهي الحكم بما أنزل الله، ولذلك كان العلماء والفقهاء يُضربون من حكام المسلمين للقبول بتقليدهم خطة القضاء ومع ذلك كانوا يمتنعون ويصمدون لأنهم يعلمون بأنه هناك قاضيا واحداً في الجنة وقاضيين في النار.
بقلم: الأستاذ عماد الدين حدوق
المحامي لدى التعقيب ومجلس الدولة في تونس



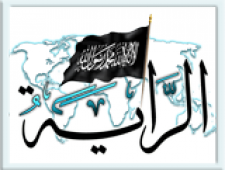







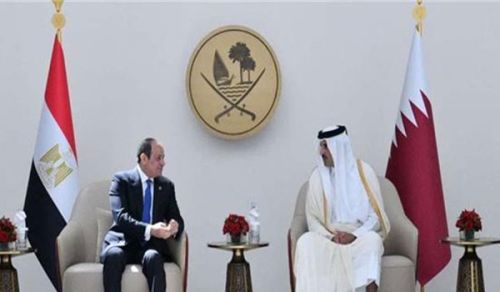

















رأيك في الموضوع