اختتمت بتاريخ 24/5/2016 في مدينة إسطنبول التركية فعاليات القمة العالمية للعمل الإنساني بمبادرة من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون الذي قال إن حجم المساعدات الإنسانية تضاعف 12 مرة خلال 15 عاماً الأخيرة ليصل إلى 245 مليار دولار، ورأى أن "دوراً مهما يقع على عاتق الدول ورؤساء البلديات والحكومات المحلية من أجل تهيئة مناخ آمن للاجئين" مشدداً على أهمية تأمين فرص اقتصادية للاجئين ودعم علاقاتهم مع المجتمع المضيف.
وشارك في المؤتمر أكثر من 50 زعيما عالميا و5 آلاف من الخبراء والسياسيين والعاملين في مجالات الإغاثة الإنسانية، وبحثت القمة "الإنسانية" سبل مواجهة الكارثة الإنسانية المتصاعدة في العالم ووضع نظام مساعدات أكثر كفاءة وفاعلية.
والهدف المعلن لهذه القمة التي غاب عنها زعماء الدول الكبرى، إعداد خريطة طريق لمساعدة أكثر من 60 مليون لاجئ ونازح عبر العالم دفعت بهم الحروب والصراعات الدولية والإقليمية إلى الموت على طرقات اللجوء القسري وفي أعماق البحار هرباً من جحيم الحروب في بلادهم كما يحصل في سوريا منذ أكثر من خمسة أعوام أو من الحروب الاقتصادية القاتلة بشكل صامت.
والقمة لم يقدر لها النجاح حسب الأهداف المعلنة وإنما إظهار الجانب الخيري والإيجابيات لدى زعماء العالم ومن خلفهم دولهم، على الأغلب لإخفاء الجانب السلبي الناتج عن الصراعات السياسية والعسكرية، وقد عبرت عن ذلك منظمة "أطباء بلا حدود" التي قاطعت القمة واعتبرتها طوق نجاة للحكومات المسؤولة عن تصاعد الاحتياجات الإنسانية متوقعة أن لا يصدر عنها أكثر من إعلان "نوايا حسنة" غير عملية.
تنعقد هذه القمة أمام مشاهدة العالم لقتل الآلاف من النساء والشيوخ والأطفال في سوريا والعراق ومعظم بلاد المسلمين، حيث يشكل النازحون منها أكثر من 90% من نسبة اللاجئين، وتحت مسمع الصيحات والآهات الإنسانية الكبيرة التي ضاق أصحابها ذرعاً بالجرائم التي ترتكب بحقهم على أيدي القوى الرأسمالية الكبرى التي تقاسمت فيما بينها النفوذ والأرباح على حساب الشعوب المستضعفة والتي رغم مآسيها، باتت عرضة لأبشع أنواع الاستغلال المادي كالهارب من الرمضاء إلى النار.
ولم تخلُ هذه القمة من الممارسات السياسية الفردية التي تدل على عدم جدية إنسانيتها المزعومة، ففي افتتاح القمة، لم ينس الرئيس التركي تذكير العالم بأن بلاده أنفقت عشرة مليارات دولار على مساعدة اللاجئين من سوريا والعراق، مضيفا أن المجتمع الدولي لم ينفق منها أكثر من 456 مليون دولار، واستغل قضية اللاجئين بتهديد أوروبا بفتح أبواب الهجرة للاجئين إليها، إذا لم تسارع الأخيرة بمنح الأتراك حرية التأشيرة لدخولها، ولم يأت على واجباته لنصرة إخوانه المسلمين في سوريا، كما كان عهد سلاطين الدولة العثمانية.
ويبدو أن الدافع وراء مشاركة أوروبا الفعالة في القمة الإنسانية هو إيجاد الحلول والدعم لمشكلة الهجرة التي باتت ورقة تهدد مصالحها السياسية والأمنية، فقد أعلنت ألمانيا، أكثر المشاركين حماساً وعلى لسان وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني (غيرك مولر): "أن الآليات الحالية للاتحاد الأوروبي المخصصة للاستجابة لأزمة اللاجئين لا توفي لهذا الغرض، واقتراحي حول أزمة اللاجئين هو تحويل 10% من ميزانية الاتحاد الأوروبي من أجل الاستجابة لهذه الأزمة وتطوير البنية التحتية".
كان واضحا على المشاركين في القمة الكلام المنمق والشعارات النظرية التي لا تعكس أي جدية حقيقية لمعالجة هذه الأزمات الإنسانية التي تتراكم منذ العقود الأخيرة ويفرزها النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي، وجرائمه وسيطرته المادية العسكرية والاقتصادية التي تسمح للمستغلين من دوله زيادة أرباحهم وثرواتهم على حساب ملايين الشعوب الجوعى والمشردين في العالم دون أي اعتبار إنساني أو أخلاقي، وتواطؤهم على الحلول السياسية من خلال المنظمات العالمية التي يسيطرون عليها كهيئة الأمم، بحيث تبقي ثغرات السيطرة مفتوحة أمامهم، فالدول الغربية الاستعمارية صاحبة النفوذ الأوسع في العالم والمنظمة الدولية، أداتها، وجدت في قمة "الإنسانية" هذه مدخلاً لمشكلة تخاف أن تنفجر في وجوهها، حيث تؤدي الصراعات والنزاعات إلى لجوء الملايين من المهاجرين إلى أوروبا، وورقة تغطي بها عيوب غياب الحس الإنساني عن سياساتها وإجرامها.
يعرف السياسيون والمفكرون المنصفون في العالم أن مثل هذه القمم هي لترقيع مآلات سياسة النظام الرأسمالي الجشع في العالم، التي تخرج عن السيطرة أثناء إرساء النفوذ والاستغلال المادي لهذا النظام، علاوة على عجز العالم بمنظماته ومؤسساته الإنسانية عن إيجاد الحل الجذري الإنساني لهذا النظام وسيطرة أدواته من منظمات المجتمع الدولي في سبيل استدامة بل وزيادة الكوارث الإنسانية من نزاعات وفقر وتلوث للبيئة.
فمنذ سقوط دولة الخلافة العثمانية عام 1924م وتمزيق الأمة الإسلامية إلى دويلات تابعة للاستعمار الغربي وإبعاد الإسلام عن كل أنظمة الحياة، والأمة الإسلامية بل والعالم كله يعاني من الفقر والتشريد والكوارث والتهجير والإبادة، على يد دول الاستعمار الرأسمالية التي تتعامل مع الناس بمبدأ الربح والسيطرة ورأس المال ولا تلقي بالاً للإنسان وحقوقه التي تتشدق بها ديمقراطيته المزيفة، وذلك رغم امتلاك المسلمين للثروات الهائلة والموقع الجيوسياسي الاستراتيجي، فالمبدأ الإسلامي ينظر بجدية إلى كرامة الإنسان وحياته ومكانته وعرضه دون اعتبار للأمور المادية مهما بلغت، ولا لمصالح الأشخاص والمؤسسات ورؤوس أموالها، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾ [الإسراء: 70]
ولا شك أن القضاء على أسباب ومنابع الكوارث الإنسانية التي أفرزها النظام الرأسمالي، تكون بداهة بنبذ وإقصاء المبدأ الرأسمالي ودوله وأدواته من التحكم والسيطرة على أنظمة الحياة في العالم، وجعل القضية المصيرية للمسلمين وإنقاذ إخوانهم في أصقاع الأرض ونصرتهم في مناطق الجوائح والتهجير والقتل والإبادة، بل وإنقاذ الإنسان كإنسان هي باستئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة التي سادت العالم قروناً طويلة، وساد أثناء وجودها العدل والطمأنينة والسلم في العالم بفضل المعالجات الشرعية التي فرضها الإسلام وطبقها المسلمون عمليا في حال حدوث المآسي التي تمس كرامة الإنسان وحياته، سواء داخل الدولة الإسلامية، أو في أي مكان في العالم، والمساعدات التي اشتهر عن الدولة الإسلامية تقديمها لشعوب العالم عند الجوائح والكوارث لهي خير دليل على جعل حياة الإنسان وكرامته مركز اهتمام المبدأ الإسلامي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ما يعرف بمجاعة البطاطا عام 1845م في أيرلندا والتي قضت على قرابة المليون أيرلندي نتيجة التمييز الديني من قبل إنجلترا ضد سكان أيرلندا، وفي ظل تخاذل الإنجليز عن نجدة رعاياها، تدخلت الدولة الإسلامية العثمانية، على الرغم من بدايات ضعفها، لنجدة فقراء الشعب الأيرلندي، فأمر السلطان عبد المجيد الأول بمساعدة مالية بلغت عشرة آلاف جنيه أسترليني، فاقت مساعدات بريطانيا التي طلبت تخفيض المساعدة لألف جنيه أسترليني، إلا أن السلطان العثماني أرسل المساعدة المالية ومعها ثلاث سفن محملة بالطعام لأيرلندا رغم الحصار الإنجليزي، وما زالت رسالة الشكر التي أرسلها وجهاء أيرلندا للسلطان عبد المجيد والدولة العثمانية محفوظة في الأرشيف العثماني بتركيا حتى اليوم.
بقلم: د. أحمد حسونة



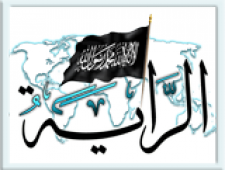







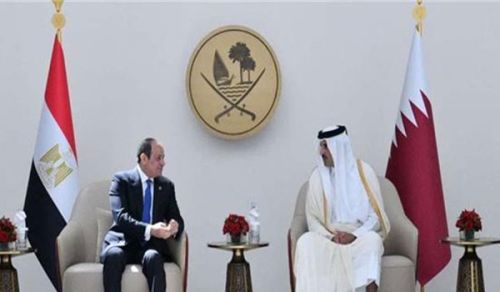

















رأيك في الموضوع