نشر شملان العيسى في الشرق الأوسط مقالة بعنوان: لماذا العداء لليبرالية والعلمانية، يمكننا تلخيص أهم ما فيها:
- إن سبب تأخر دخول الدول العربية عالم الحضارة والحداثة والانفتاح الديمقراطي هو القنوات الدينية والأحزاب الدينية التي تحض على معاداة الآخر وتثير النزعة الطائفية.
- العلمانية والليبرالية ليست دينا، وهي حركة فكرية نشأت نتيجة إقحام الدين فيما لا علاقة له به من سياسة وثقافة واقتصاد وعلم واجتماع!
- تدعو الليبرالية إلى الحرية الفردية والسياسية والاقتصادية وعلى الفرد أن يخضع لسلطة القانون واعتماد حرية العقيدة والاقتصاد الحر، وهذه الأفكار تدعو لتحرير الإنسان!
أقول وبالله التوفيق: من الواضح أن الكاتب يحرص على زج مصطلحات متناقضة ومفاهيم متضاربة ليخرج من بين فرثها ودمها لبناً! وأنّى له ذلك، وسأنقض مقالته في ثلاث حلقات، مبينا أن مفاهيم الديمقراطية والعلمانية والليبرالية متناقضة، تتناقض مع نفسها ومع بعضها بعضاً، وأنها دين، إذ تتناول شئون الحياة من اقتصاد واجتماع وغيرها، وأنها سبب دمار البشرية، وأنها لا تقبل بالآخر بأي شكل من الأشكال! وسأبين سبب وجوب معاداتها...
فالمفكرون الغربيون حين بحثوا في النظريات القديمة واهتدوا إلى الإيزونوميا (أي المساواة في الحقوق القانونية) وهي الفكرة الأب الشرعي لما يسمى اليوم بالديمقراطية، والإيزيجوريا (أي حرية التعبير) والإيزوبسيفيا (الحق في التصويت)، خلطوا هذه الاتجاهات الفكرية السياسية التي نشأت في أثينا، تحت مسمى الديمقراطية -تلك الفكرة التي كانت منبوذة في أثينا - وروجوا لفكرة أن أثينا ترمز لفكرة نظام الأكثرية - وما كانت كذلك - مقابل أسبارطة التي تمثل الأوليغارخية، أي حكم القلة، فتبنى الغربيون نظام الأكثرية، أي الديمقراطية، ولكنهم وقعوا في أول مأزق، فالديمقراطية تقوم على أساس إخضاع الأقلية لحكم الأكثرية لا على أساس ضمان حقوق الأقلية ولا أن يمثل القانون الذي يجري التصويت عليه ما يرى فيه الأقلية حقوقا لهم، فلو رأوا فيه ضمانة لحقوقهم لصوتوا له، وبتصويتهم للرأي النقيض فإن ما رأوه من حق لهم في الرأي النقيض لا يحققه الرأي الذي تم التصويت له، وبالتالي فالديمقراطية لا يمكن أن تضمن حقوق الأقلية ولا أن ترعى مصالحهم، بل عليهم الخضوع لما رأته الأكثرية بغض النظر عن صوابية الرأي الذي رأته الأكثرية أو خطئه، لأن المعيار الوحيد المراعى هو أن يمثل رأي الأكثرية، لذلك احتيج في الغرب إلى الليبرالية، التي تقوم على حماية حقوق الأفراد والأقليات، لذلك يفرق بين الديمقراطية الليبرالية، والديمقراطية اللاليبرالية.
لاحظ أيها القارئ الكريم أن الديمقراطية تحارب ديكتاتورية القلة، وأن الليبرالية تحارب ديكتاتورية الكثرة، لذا والفوا بينهما هذه الموالفة العجيبة ببدعة: الديمقراطية الليبرالية! وهذا من فذلكات اللعب بالألفاظ حين يظهر عوار نظام ما، فتجد أنهم يسندونه بنقيضه كي لا يظهر بمظهر النظام المجحف، فمن السماجة بعد أن نَظَّرَ المنظرون للفكر الديمقراطي ما نظَّروه أن يتبين لهم أن هذا النظام ديكتاتوري في حكمه على الأقليات، وأنه لا يضمن لهم أي حق، ويخضعهم لرأي الأغلبية، وإن كان فيه تعدٍ على حرياتهم، أو على رغبتهم بتشريع آخر، أو رئيس آخر ينتخبونه، لذلك لم يجدوا بُدّاً من ترقيعه بنقيضه، وهو مذهب الفردية، أي الليبرالية، فكيف سيتم التزاوج بين مذهب يحارب الفردية ويحارب تحكم القلة، مع مذهب يمنع الكثرة من الاستئثار بمقاليد تشريعات أو نظم تمنع الأقليات أو الأفراد حقوقهم وتجبرهم على الخضوع للأكثرية؟!!
ثم إن العلمانية، قامت على أساس فصل الدين عن الدولة، ثم تطورت لتصبح فصل الدين والقيم والأخلاق عن الحياة، فلا بد للمشرع مثلا، أو للفكر الذي يراد له أن يسود العلاقات المجتمعية، أن يكون مبنيا على أساس أن يزيل من فكره، وهو يحكم على قضية ما، أي تأثر بقيم مصدرها الدين أو الأخلاق أو العادات، أو النظرة الإنسانية أو ما شابه، ليصل إلى ما يسمى الخلو من القيم، value free، فهذا الخلو من القيم ضمانة لأن تكون العلمانية محايدة، فالتشريعات محايدة، والعلم محايد، والعلاقات التي تسود المجتمع قائمة على أساس محايد، وذلك لأن نظرتهم إلى الدين أنه هو السبب في التأخر وفي لجم العقل وكبح جماحه، فلا بد من تنحيته حال الحكم على الشيء، حتى ينطلق العقل ويسمو ولا يتأثر بما يكبحه.
والواقع أن هذا مما يستحيل وجوده في الواقع، فخذ مثلا مسألة الحكم على الزنا أي العلاقة الجنسية خارج إطار الأسرة والزواج، لو أراد متشرع أن يحكم عليها ليسن قانونا يحرمها أو يبيحها، فإنه سينظر إلى أنها مشكلة معينة بحاجة لرأي، فإذا نحى جانبا نظرة الدين إليها على أساس أنها محرمة، ونحى جانبا الأخلاق على أساس أن هذه العلاقة لا أخلاقية، ونحى جانبا القيم الإنسانية، على أساس أن القيم الإنسانية قد تعتبر أن هذه العلاقة فيها هدر لكرامة الأسرة، أو كرامة المرأة، أو الرجل، أو من جانب آخر القيم التحررية الليبرالية التي ترى أن هذه العلاقة تكرس الحرية والحق في ممارسة ما يحقق الحرية،... الخ، فهو عليه أن ينحي كل هذه القيم سواء تعارضت أو تشاركت في النتيجة، وإن اختلفت في المنطلقات، أقول، حين ينحي كل هذه القيم جانبا، فإنه لن يستطيع إصدار أي حكم على المسألة، لأن أساس الحكم على مسألة ما هو تحقيقها لقيم معينة، أو منعها لأنها تعارض تحقيق قيم معينة، فكيف به وهو ينحي كل القيم جانبا؟
هذه الإشكالية تجعل إصدار الحكم على أي قضية أمرا مستحيلا، فإن هو منع القيم التي أساسها الدين، وسمح بالقيم التي أساسها الليبرالية، فإنه ولا شك سيقع في التناقض، كما قال الشاعر: حرام على بلابله الدوح، حلال على الطير من كل جنس؟ (...يتبع)











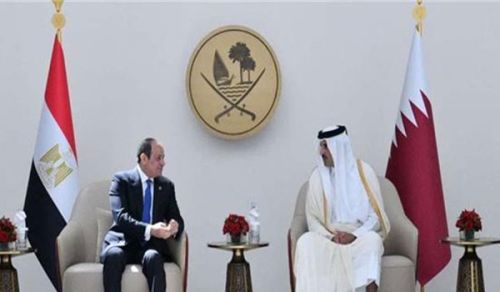

















رأيك في الموضوع