لقد شرع الله عز وجل أحكام الدين، فكان القيام بها بالنسبة للمسلمين والتزامها هو طاعة لله وعبودية له سبحانه، ولكن الله جل وعلا قد شرعها كذلك من ناحية أخرى لتستقيم بها حياة الناس في هذه الدنيا وتنتظم شؤونهم، وعليه فإنه إذا كانت أحكام الله تعالى ودينه هي الصراط المستقيم ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ﴾ فإن الخروج عنها هو اعوجاج، والاعوجاج له آثاره، وإذا كانت أحكامه كما وصفها جل وعلا هي حدوداً، فإن الحدود ضوابط، وتجاوزها له آثاره كذلك من التيه والتخبط والظلم والظلمات ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، وعليه فقد كان كل تفريط وتغييب لحكم شرعي لا محالة يقود إلى خلل في الحياة وضنك، وله أثر مادي وواقع في حياة الناس ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً ...﴾.
ومن هنا، فإن كل حكم من أحكام الله إن غاب كانت له آثار تعقبه، ولأن المجتمع في الإسلام ليس مكونا من الملائكة، بل هو من بشر يخطئون، فإن خلل المعصية إن كان جزئيا أو فرديا فإن التقوى منه وقاية، وإن وقع فإن التوبة قد تحده والعقوبة تزجره أو تجبره، وبقية الأحكام المطبقة تحصر تأثيره، أي أن هناك بيئة من الأحكام تقي أولا وتردع ثانيا وتجبر ثالثا، ولكن الخطر يكون إذا غابت مجمل أحكام الشرع من واقع الحياة ومن التطبيق، فإن الخلل حينها يكون عاما وطاما وشاملا، حتى يصير الواقع إلى ما نحن فيه في هذه الأيام، إذ لا يكاد يوجد في حياة الناس إلا الخلل، وهو خلل يكاد يكون شاملا في كل زاوية وتفصيل ناجم عن غياب أحكام الإسلام في جملتها من كونها أساس التشريع والقوانين والحياة، وهو الضياع الذي عبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: «لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، فَأَوَّلُهُنُّ نَقْضاً الْحُكْمُ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ».
إن هذا الانتقاض قد بدأ فعلا في عرى الإسلام بالحكم والسلطان، وقد كان ذلك بزوال الخلافة، إذ إن الحكم هو الناحية التي تمسك بمجامع الأحكام الشرعية المنظمة لشؤون الحياة كافة في الاقتصاد والاجتماع والتعليم والعقوبات والمعاملات والسلوكيات، والسلطان هو الضامن لتطبيق الإسلام، حتى إذا انفرطت ناحية الحكم لم يعد هنالك ضمانة وسلطان لحفظ بقية الأحكام، وقد كان، إذ إنه بغياب نظام الحكم في الإسلام غابت أحكام الإسلام، وسحبت من التداول في حياتهم، واستبدلت بها قوانين أخرى في شتى المجالات، فكان لكل ذلك أثر مادي محسوس وملموس في حياة الناس، وهو أثر من الخراب والدمار والضنك وحالة من البؤس صارت مستفحلة.
فمثلا بغياب عروة الحكم التي أشار إليها الحديث فقدْ فقَدَ المسلمون ركيزة الوحدة، عندما قسمت دولتهم فصارت دويلات وشظايا، وبالتالي فقدوا كل منافع القوة وقيمة الثروة الهائلة الموجودة لديهم، حتى إذا احتلت بلد من بلدانهم أو تسلط العدو على بعضهم، كان العجز والخذلان وخيانة الحكام، وانعدمت النصرة رغم وجود الجيوش، بل لقد صار القطر أو الناحية يعاني العطش والجفاف رغم وجود الأنهار في القطر المجاور! وصار القطر لا يجد الطاقة والكهرباء والقطر المجاور يفيض بالطاقة! وصار القطر يقترض المال من مؤسسات الاستعمار والهيمنة المالية الغربية والقطر المجاور يعطل الثروة الفائضة بإيداعها في بنوك الغرب!! وبذلك غاب معنى التكامل عندما عطلته الأسلاك الشائكة والحدود التي قطعت أجزاء الجسم الواحد.
ومثل غياب نظام الحكم والسلطان، كانت آثار غياب بقية أنظمة الإسلام في الحياة وهي التي استبدلت بها قوانين الغرب العلمانية الكفرية، حيث صار الناس يعانون من آثار تطبيق تلك القوانين عليهم التي أنتجت في حياتهم الفقر والضر والبؤس والشقاء.
فمثلا، ومع كثرة الجرائم وانتشارها وخصوصا جرائم القتل، فقد لمس الناس الحاجة إلى حكم القصاص وأثر غيابه، وصار يستذكر مع كل جريمة، ويذكر غياب الردع في قوانين العقوبات حيث انتعشت الجريمة، تلك القوانين التي لا تردع ولا تزجر، ومثلا مع وجود قوانين الربا - ذلك الربا الذي حرمته أحكام الإسلام تحريما شديدا - وما نتج عنها من مؤسسات ربوية، فقد تحولت حياة الناس وأموالهم لتكون رهنا لدى البنوك التي أغرقت الناس في الديون وفي القروض وفي المحرمات، ومع تغييب الأحكام الشرعية التي تتعلق ببيت المال من حيث الإيرادات والنفقات، من خراج يقوم على إحياء الأرض الزراعية وإنتاجها، وملكية عامة للثروات والموارد الهائلة، ومثيلات ذلك، تعود للناس وينفق منها على شؤونهم، فقد اعتمدت الأنظمة القائمة في بلاد المسلمين النمط الغربي الرأسمالي، ونظم الغرب الضريبية التي تسطو على مقدرات الناس وجهودهم وأقواتهم، حتى صارت أثمان السلع التي تباع في الأسواق وتشترى أغلبها مكون من الضرائب، والتي هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار وفي الغلاء وفي الفقر، وهو ذلك الشكل الذي حرمه الإسلام من الضرائب واعتبره أكلاً لمال الناس بالباطل، وكذلك أهملت الأرض الزراعية والإنتاج الزراعي حتى غدت بلدان المسلمين عالة على غيرها حتى في خبزها، بل وأهدرت تلك الأنظمة موارد المسلمين العامة وجعلتها ملكا للخاصة من الغرباء الأجانب والغربيين الأعداء!
إن ما قد يقال عن نواحي الاقتصاد والعقوبات يقال كذلك عن سياسات التعليم التي أُفرغ محتواها من العقيدة وما رافق ذلك من أجواء الفساد، حتى أنتجت بيئة فاسدة يقتل فيها الإبداع وتنحدر الأخلاق وترتع الجريمة، وكل ذلك مشاهد ملموس.
ولذلك كان علاج هذه المشكلات جميعها دون ربطها بأسبابها الأصلية وهي غياب أحكام الإسلام، مصيره إلى الفشل، وكان اجترار الحلول من البيئة العلمانية وأفكارها ذاتها التي هي أساس الداء لا يعني إلا مزيدا وتفاقما للمشكلات ذاتها، وكان ربط المشكلات بأسبابها الحقيقية وهي غياب معالجات الإسلام ونظام حكمه قبل ذلك والمتمثل في الخلافة، وحلوله المتصلة بتلك المشكلات هو جزء من الحل، وذلك بزيادة وعي المسلمين على آثار غياب شرع ربهم، حتى تصبح مطالبهم بحل مشكلاتهم مرتبطة بلا انفكاك وعن وعي وحس وإدراك بالمطالبة بأحكام الإسلام ورفض كل ما سواها، وذلك بالإضافة لما تقتضيه تلك المطالبات في المقام الأول، عقيدتهم وإيمانهم وعبوديتهم وطاعتهم لربهم.
بقلم: الأستاذ يوسف أبو زر
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الأرض المباركة (فلسطين)



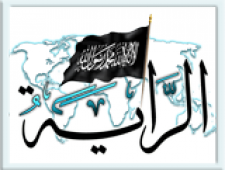

























رأيك في الموضوع