عند ذكر مصطلح الديمقراطية يتبادر للذهن ما أراد الغرب ترويجه وتركيزه في الأذهان ألا وهو ارتباطه بالحرية. فمن المفترض "نظريا" في الديمقراطية كفلسفة ووجهة نظر عن الحياة أنها تنشر في المجتمع وتربي أبناءه على الحرية وفي مقدمتها حرية الاعتقاد أو التدين والحرية الشخصية.
ولكن التطبيق العملي لمفاهيم الحرية يتعارض مع النظرية، وأخص بالذكر هنا ما يتعلق بالاعتقاد والتدين، والحرية الشخصية تجنبا للوقوع في مقاضاة المصطلح أمام مقولة "تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية غيرك"، والتي يعتبرها البعض مخرجا آمنا من السقوط في التناقض لمعنى الحرية "المطلقة"، فمن المعلوم بالضرورة أن مسألة الاعتقاد والتدين في ديمقراطيتهم مسألة شخصية بحتة وهي أساس فصل الدين عن الحياة.
من الملاحظ أن هذا التعامل مع هذه الحرية كان جاريا حتى منتصف الثمانينات من القرن الماضي دون حاجة لتعديلات أو إجراءات قانونية، تحدُّ من مظاهر التدين عند القساوسة أو الراهبات، وتعدد المذاهب والجماعات الدينية، أو تبديل الديانة أو الخروج من الكنيسة أو غير ذلك، بل إن كثيرا من المدارس والمستشفيات وحضانات الأطفال والمؤسسات التعاونية كانت تنتسب للكنيسة، وترفع الشعارات الكنيسية على المباني وفي الغرف والقاعات.
ساد التسامح مع المظاهر الإسلامية التي كانت لا تشكل تهديدا مجتمعيا، مبنيا على مفهوم حرية الاعتقاد وحرية الرأي والحرية الشخصية، حيث كان على سبيل المثال أكثر من مليوني مسلم من الأتراك في ألمانيا الغربية يعيش أغلبهم حياة إسلامية شبه انعزالية في المجتمع الغربي، ومثلهم في بلجيكا وفرنسا وهولندا وغيرها من بلاد الغرب، ولم تسجل حالات اعتداء مُنظَّمَة ضد هؤلاء "الغرباء" أو الطوائف الدينية الصغيرة، فقد كان الغرب بمبدئه منشغلا في مواجهة المبدأ الشيوعي، فكريا وعسكريا، وكان مطمئنا إلى عدم المواجهة مع الإسلام، حيث استطاع إنهاء وجوده العملي بالقضاء على دولته (الخلافة العثمانية) وقوته العسكرية التي كانت تشكل تهديدا له. وكان ظاهرا فشلُ المجتمعات الغربية التي استقطبت المسلمين في صهرهم في بوتقتها فظلوا منعزلين، على خلاف مبدأ الإسلام الذي صهر الشعوب والقبائل والبلاد التي فتحها في بوتقة الإسلام فكانوا جميعا إخوة ونسيجا متجانسا رغم اختلاف ألوانهم وألسنتهم.
وما أن انهار الاتحاد السوفييتي، العدو الظاهر للغرب، حتى صار لزاما على الغرب إيجاد عدو بديل يتستر خلفه فلا تنكشف عورات مبدئه وعجزه، فتم رفع شعار "الإسلام عدو بديل" عام 1991 على لسان ديك تشيني وزير الدفاع الأمريكي آنذاك، وذلك في المؤتمر العالمي السنوي للشؤون الأمنية في مدينة ميونيخ، وبعد هذا بقليل كان التحوّل إلى "مكافحة الأصولية" تمويهاً لتجنب كلمة "الإسلام" ومن ثم الانتقال إلى مصطلح "الحرب ضدّ الإرهاب". وسرعان ما انتشر في خضم هذه التحركات مصطلح الإسلاموفوبيا الذي صار سائدا في الإعلام وبين الساسة وفي المجتمع، مما أدى إلى ظهور حركات سياسية واجتماعية ودينية، تعادي الإسلام مباشرة وتنكر كل مظاهر الارتباط في الإسلام في المجتمع الغربي.
ظاهرة الإسلاموفوبيا بدأت مع ظهور الإسلام السياسي، وعودته لتهديد الغرب، فاضطر الغرب إلى التقدم بنفسه للدفاع عن مصالحه بعدما كان أوكلها لعملائه الذين فشلوا في التخلص من الإسلام كمبدأ وطريقة عيش لا تقبل بالغرب، فصار الصراع وجها لوجه، وذلك عندما عجز المبدأ الغربي عن مواجهة الإسلام فكريا ومقارعة الحجة بالحجة فلجأ إلى المواجهة العسكرية. وقد استغل ضعف المسلمين لغياب القيادة الواعية المخلصة أيما استغلال للقضاء على الخطر المرتقب ولمنع المسلمين من النهضة، التي صارت قاب قوسين أو أدنى.
والسؤال المطروح: ألا يتعارض حظر الفكر المخالف للديمقراطية (الإسلام) أو منع رموزه مع ذات المبدأ القائم على الحريات؟
الجواب على ذلك، نعم، ولهذا صار لا بد له من افتعال أساليب للخلاص من المأزق الفكري، فعمد إلى الصراخ إذ أحس بالهزيمة. ولكي يغطي عورته لجأ إلى التضليل الفكري وإظهار محاسن مبدئه مقارنة مع ما ادَّعى أنه إسلام في دول مثل أفغانستان والسعودية وإيران، وحركات مثل القاعدة وتنظيم الدولة، فصور المسلمين بأبشع الصور وأقبح الصفات، وراح يبرر اعتداءاته وحروبه بحجة حفظ أمنه واستقرار مجتمعه، وهي حقيقةً حروب استعمار، ودَعَم هذه الحروب بسياسة الكراهية والخوف والتميز، حتى انتشرت بين الناس صورة وحشية المسلم وكراهية الإسلام والبطش والتنكيل والتفجير والجريمة ضد الأبرياء وغيرها من أساليب التخويف التي يمارسها الغرب، وقد توافقت الدول على هذا الأسلوب وتواطأت عليه كي تنقذ ما بقي من واجهةٍ أوشكت على الانهيار لتفضح التركيبة المهلهلة والمجتمع اللاإنساني الذي تم بناؤه على أساس مبدأ الرأسمالية.
ولكن هل الذي يدَّعي حرية التفكير والاعتقاد بحاجة إلى هذا الأسلوب الرخيص؟
نعم هو كذلك، لأن هشاشة الفكر وضحالة القاعدة تؤديان إلى انهيار المبدأ بسرعة إذا وجد ما يقابله، ويعمل على زعزعة الثقة به. ولكن غياب البديل أو تغييبه يطيل عمر المبدأ (ستاتيكياً) ويبقى على جموده، حتى يأتي من يحركه فينهار ويختفي.
من الملاحظ أن ظاهرة العداء ضد الإسلام تتزايد بتزايد وتيرة مطالبة الشعوب الإسلامية بالتحرر. وما هذه الهجرة والتشريد إلا بسبب جشع الغرب ونهبه لخيرات البلاد، مما ألجأ مُلَّاك الخيرات الشرعيين إلى الهجرة من بلادهم طلبا للحياة. وهناك يواجهون في مجتمع لا إنساني يخشى فقدان حياة الرفاهية ورغد العيش حين يشاركه المهاجر ببعض ماء أو طعام لم تتوفر في بلاده لأن الغرب نهبها ولم يُبقِ لهم رمق عيش بسبب جشعه الرأسمالي.
إحصائيات مكتب الجنائية الألماني الاتحادي تؤكد اطراد حالات الاعتداء على ملاجئ المهاجرين من 18 حالة عام 2011 إلى 1578 حالة عام 2016، منها 385 حالة اعتداء مباشر على لاجئين عام 2016، في حين سجلت 81 حالة عام 2014.
نعم، إن الغرب يرى التهديد واقعا، فيعمل على اقتلاعه، ولكنه يخالف بذلك قواعده الفكرية ومبدأه الذي يدعو له. والدوَّامة التي وقع فيها الغرب لن تنهيها الحرب، وما هي إلا أيام وتكون الساحة مكشوفة لولوج الإسلام في كل بقعة من الأرض، كما وعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، عن تميم الدَّاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «ليَبْلُغن هذا الأمرُ ما بَلغَ اللَّيلُ والنَّهارُ، ولا يَترِكِ اللهُ بَيتَ مَدَرٍ ولا وَبَرٍ إلَّا أدْخلهُ اللهُ هذا الدِّين، بِعِزِّ عَزِيزٍ أو بِذُلِّ ذَليلٍ، عِزًّا يُعِزُّ اللهُ به الإسلامَ، وذُلًّا يُذِلُّ اللهُ به الكُفر».
بقلم: م. يوسف سلامة – ألمانيا



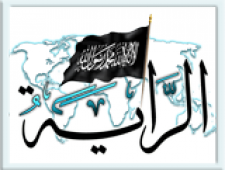

























رأيك في الموضوع