اعتنى الإسلام بالصحة وعدّها جزءاً من العناية بقوة المسلمين، فالإسلام يحرص على سلامة الأجسام التي تجري فيها عروق الصحة والعافية، ولذلك حارب الأمراض، ودعا إلى التداوي، وأوجد أساليب شتّى للوقاية من الأمراض، ووضع قواعد الحجر الصحي عند ظهور المرض في منطقة ما، حيث منع الخروج أو الدخول إليها حتّى تنحصر رقعة الداء.
كانت التوجيهات النبوية الخاصة بالتدابير الوقائية تجاه العدوى والأمراض الوبائية من أوائل ما وضع من قواعد لِمَا يُعرَف حديثاً بالحجر أو العزْل الصحي؛ حيث بيَّن المصطفى صلى الله عليه وسلم الإجراءات الصحيَّة في حالات الأوْبئة، فقال: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ»، وأيضا حرَص صلى الله عليه وسلم على عدم انتقال العدوى من المرضى للأصحَّاء، فقال: «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ».
أثناء رحلة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجابية من أرض دمشق مرَّ بقومٍ مجذومين من النصارى، فأمر أنْ يُعطوا من الصدقات، وأنْ يجرى عليهم القُوت، كما أمَر امرأةً مجذومةً كانت تطوف بالبيت أنْ تجلس في بيتها؛ حتى لا تؤذي الناس، إلى جانب موقفه الشهير في طاعون عمواس؛ حيث حصر المرض في منطقة الشام؛ ممَّا أدَّى إلى السرعة في القضاء عليه.
إذا فالصحة والتطبيب من الواجبات على الدولة بأن توفرهما للرعية، حيث إن العيادات والمستشفيات، مرافق يرتفق بها المسلمون، في الاستشفاء والتداوي. فصار الطب من المصالح والمرافق التي يجب على الدولة أن تقوم بها لأنها مما يجب عليها رعايته عملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». وهذا نص عام على مسؤولية الدولة عن الصحة والتطبيب لدخولهما في الرعاية الواجبة على الدولة. وهناك أدلة خاصة على الصحة والتطبيب:
أخرج مسلم من طريق جابر قال: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيباً فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقاً ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ». وأخرج الحاكم في المستدرك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: (مَرِضْتُ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَرَضاً شَدِيداً، فَدَعَا لِي عُمَرُ طَبِيباً فَحَمَانِي حَتَّى كُنْتُ أَمُصُّ النَّوَاةَ مِنْ شِدَّةِ الْحِمْيَةِ).
والدولة الإسلامية تشرف على صُنع الدواء وإنتاجِه مباشرةً، لما أخرجه الحاكم في المستدرك، قال: «ذَكَرَ طَبِيبٌ الدَّوَاءَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ r، فَذَكَرَ الضِّفْدَعَ يَكُونُ في الدَّوَاءِ، فَنَهَى النَّبِيُّ عَنْ قَتْلِهِ»، وَأَخرج البيهقي وأبو داود عن عبد الرحمن بن عثمان قال: «سَأَلَ طَبِيبٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا في دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ عَنْ قَتْلِهَا»، ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه يَدُّل بدلالة الإشارة على أن الدولة تشرف على إنتاج الأدوية، إذ الحديث سيق لبيان النَّهي عن قتل الضفدع، لكنهُ يفيد أيضاً بدلالة الإشارة أن الدولة لن تمنع صناعة نوع ما من الأدوية.
وعملاً بالأدلة القاضية بأن التطبيب واجب على الدولة مجاناً لرعيتها، وكون الإمام راعياً وهو مسؤول عن رعيته، فإنَّ الدولة تُوفر الدواء للمرضى، إما بشرائه من مصانِع الدواء وشركاته في الدولة أو في الخارج، وإمَّا بإنشاء مصانع للدواءِ تملكها الدولة وتنتج الأدوية المطلوبة.
ولأنَّ الدواء حاجة حيوية قد يُؤدي نقصها أو فقدانها إلى ضرر على الفرد والجماعة، فإنَّ الدولة تبذل قصارى جهدها في تحقيق الاكتفاء الذاتي في صُنع الدواء، حتى لا تحتاج إلى استيراد الدواء، وبالتالي تتعرض لابتزاز الدول الكافرة أو ضغوطها السياسية، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾. وإذا استورد الأفراد أو الدولة الدواء من دول أخرى، فلا بد أن يُخضعَ الدواء المستورد للفحوص والتحليل على يد الصيادلة والكيميائيين في الدولة قبل أن يُصدر ترخيص بجواز استيراده، خصوصاً وأنَّ شركات الأدوية العالمية لم تتورع في السابق عن بيع شحنات من الدواء الفاسد للمسلمين. وصحيح أن دليل البيع والتجارة عام لقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، إلا أن القاعدة الشرعيةَ تقضِي بأنَّ الشيء المباح إذا كان فرد من أفراده يُؤدي إلى ضرر، يمنع ذلكَ الفرد ويبقى ذلك الشيء مباحاً.
إنَّ المصانع في الدولة الإسلامية ومنها مصانع الدواء تقوم على أساس الصناعة الحربية، ولذلك تكون مصانع الدواء (سواءً التابعة للأفراد أم الدولة) مُعدة وقابلة دائماً لمتطلبات الصناعة الحربية والمضادات الحيوية والتطعيمات ضد الأسلحة البيولوجية على أوسع نطاق ممكن وفي أسرع وقت. والدولة الإسلامية مسؤولة عن الإعداد الوقائي ضد انتشار الأوبئة والفيروسات، وعنِ التهيئة المسبقة لمواجهة هذه الكوارث حال وقوعها. غير أن كون الدولة الإسلامية هي المسؤول الأول عن علاج آثار مثل هذه الكوارث لا يعني أنَّ المسلمين كأفراد معفون من المساعدة والمساهمة في جهود التصدي للكوارث، لأنَّ أدلة إزالة الضرر وأدلةَ وجوب إغاثة الملهوف والمصاب أدلة عامة، تشمل الدولة والأفراد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم : «مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ». وقولِهِ صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ، وَلا يَخُونُهُ، وَلا يُسْلِمُهُ فِي مُصِيبَةٍ نَزَلَتْ بِهِ». وقولِهِ صلى الله عليه وسلم وشبك أصابعه: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً». كل هذه الأدلة عامة توجِب إغاثة الملهوف على أفراد المسلمين كما توجِبها على الدولة، ولذلكَ فإنَّ الدولة تجند وتستعين بالرعية المسلمين في مجهود الإغاثةِ حال وقوعها، وتهتم بتنظيمهم للاستفادة القصوى من مجهودهم وحمايتهم حال عملهم الإغاثِي والتنسيق بينهم وبين الكوادر الرسمية المختصة. كما وأنَّ للدولة الإسلامية أن تفرض الضريبة على أغنياء المسلمين بما يفضل عن حاجاتهم بالمعروف للإنفاق على المجهود الإغاثي إذا لم تكف الأموال في بيت المال لذلك.
أمير المؤمنين عمر بن الخَطاب رضي الله عنه أمد الأعراب في عام الرمادة بالإبل والقمح والزيت من كل أرياف المسلمين، حتى بلحت الأرياف كلها (أَيْ أَجْهَدَتْ وَتَعِبَتْ وَلَمْ تُنْبِتْ شَيْئاً)، مما جهدها ذلك. وكان عام الرَمَادة عام قحط وجوع، سمي بذلك لأنَّ الأرض اسوَدَّت من قلة المطر حتى عاد لونها شبيهاً بِالرماد، أو لأنَّ الريح كانت تَسفِي تراباً كالرماد، حتى بلغ عدد الأعراب الذين وفدوا إلى المدينة طلبا للقوت أكثر من خمسين ألفا، وذكر ابن كثير في البداية والنهاية: (كتب عمر رضي الله عنه إلى أَبي مُوسى رضي الله عنه بالبصرةِ أَنْ يا غَوْثَاهُ لأُمَّةِ محمدٍ، وكتبَ إلى عمرو بنِ العاصِ رضي الله عنه بمصرَ أنْ يا غَوْثَاهُ لأُمَّةِ محمدٍ، فبعثَ إليهِ كلُّ واحدٍ منهُما بقافلةٍ عظيمةٍ تحملُ البُرَّ وسائرَ الأُطْعِمَاتِ، وَوَصَلَتْ ميرةُ عمرو رضي الله عنه في البحرِ إلى جدَّةَ ومنْ جدَّةَ إلى مكَّةَ). وكذلك فعل عمر مع سعد بن أبي وقاص في العراق ومعاوِيَة في الشَّام، ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات.
وفي المقابل، إذا كانت الكارثة في دولة من دولِ الكفرِ، فإنَّ للدولة الإسلامية أنْ تساعد في الأعمال الإغاثيّة بإرسال الطواقم المُخْتَصَّة أو المساعدات، وفقَ ما يراه الخليفة من مصلحةٍ للدولة وللدعوة إلى الإسلامِ، على أنْ لا تُؤدي هذه المساعدات إلى تقوية الدولة المنكوبة عسكريّاً.
وقد استجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستغاثة قريش، وكتب إلى ثمامة بن أُثال الحنفِي بأن يسمح للميرة بالوصول إلى قريش وهي على الكفر وعداء الإسلام آنذاك، وذكر ابن هشام ذلك في سيرَته فقال: «خَرَجَ أي ثُمَامَةُ إلَى الْيَمَامَةِ، فَمَنَعَهُمْ أَنْ يَحْمِلُوا إلَى مَكّةَ شَيْئاً، فَكَتَبُوا إلَى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إنّكَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرّحِمِ وَإِنّكَ قَدْ قَطَعْتَ أَرْحَامَنَا، وَقَدْ قَتَلْتَ الآبَاءَ بِالسّيْفِ وَالأَبْنَاءَ بِالْجَوْعِ، فَكَتَبَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إلَيْهِ أَنْ يُخَلّيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْحَمْلِ».
بقلم: الأستاذ حامد عبد العزيز



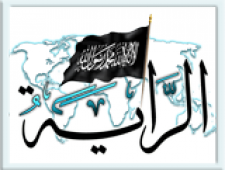

























رأيك في الموضوع